ليست مجرد مقالات ..
“إننا نتعلم الأبجدية من أجل أن نقول شيئاً مختلفا عما يقوله الآخرون.. من أجل أن نقول جملة أجمل، كلمة أفضل، من أجل أن نصل لمعنى أكمل.. إننا نتعلم الأبجدية لا لنردد ماقاله الآخرون، ولكن كي نقول الصواب.. والصواب فقط.”
أحمد
خيري العمري، ألواح ودسر
(مُتَجَدِد)
*****
*****
التوبة كـ "قصة حب"
أنت منذ الآن غيرك!
لـ محمود درويش
هل كان علينا أن نسقط من عُلُوّ شاهق، ونرى دمنا على أيدينا...
لنُدْرك أننا لسنا ملائكة.. كما كنا نظن؟
وهل كان
علينا أيضاً أن نكشف عن عوراتنا أمام الملأ، كي لا تبقى حقيقتنا عذراء؟
كم
كَذَبنا حين قلنا: نحن استثناء!
أن تصدِّق نفسك أسوأُ من أن تكذب على غيرك!
أن نكون ودودين مع مَنْ يكرهوننا، وقساةً مع مَنْ يحبّونَنا - تلك
هي دُونيّة المُتعالي، وغطرسة الوضيع!
أيها الماضي! لا تغيِّرنا... كلما ابتعدنا عنك!
أيها المستقبل: لا تسألنا: مَنْ أنتم؟
وماذا تريدون مني؟ فنحن أيضاً لا نعرف.
وماذا تريدون مني؟ فنحن أيضاً لا نعرف.
أَيها الحاضر! تحمَّلنا قليلاً، فلسنا سوى عابري سبيلٍ ثقلاءِ الظل!
الهوية هي: ما نُورث لا ما نَرِث. ما نخترع لا ما نتذكر. الهوية هي
فَسادُ المرآة التي يجب أن نكسرها كُلَّما أعجبتنا الصورة!.
*****
______________________________________________________________________________________________
القُشور واللُّباب
لـ جُبران خلِيل جُبران
ما شربت كأساً علقميَّة
الاّ كانت ثمالتها عسلاً.
وما صعدت على عقبة حرجة
الاّ بلغت سهلاً أخضر.
وما أضعت صديقاً في
ضباب السّماء الاّ وجدته في جلاء الفجر.
وكم مرّة سترت ألمي
وحرقتي برداء التجلُّد متوهِّماً أن في ذلك الأجر والصَّلاح، ولكنني لمَّا خلعت
الرِّداء رأيت الألم قد تحوَّل الى بهجة والحرقة قد انقلبت برداً وسلاماً.
وكم سرت ورفيقي في عالم
الظُّهور فقلت في نفسي ما احمقه وما أبلده، غير أنني لم أبلغ عالم السِّر حتى
وجدتني الجائر الظًّالم وألفيته الحكيم الظريف .
وكم سكرت بخمرة الذَّات
فحسبتني وجليسي حملاً وذئبا، حتى إذا ما صحوت من نشوتي رأيتني بشراً ورأيته بشراً.
أنا وانتم أيّها الناس
مأخوذون بما بان من حالنا، متعامون عمّا خفي من حقيقتنا. فإن عثر احدنا قلنا: هو
السَّاقط، وان تماهل قلنا: هو الخائر التَّلف، وان تلعثم قلنا هو الأخرسُ، وان
تأوه قلنا تلك حشرجة النَّزع فهو مائت.
إننا مشغوفون بقشور "أنا" وسطحيات "أنتم" لذلك لا نبصر ما أسرّه الرُّوح إلى "أنا" وما أخفاه الروح في "أنتم".
وماذا عسى نفعل ونحن
بما يساورنا من الغرور غافلون عما فينا من الحقِّ ؟.
أقول لكم ، ورُبَّما
كان قولي قناعاً يغشي وجه حقيقتي، أقول لكم ولنفسي: إنّ ما نراه بِأَعيننا ليس بأكثر من غمامة تحجُبُ عنا ما يجب أن نشاهده
ببصائرنا. وما نسمعه بآذاننا ليس إلا طنطنة تُشوِّش ما يجب أن نستوعبه بقلوبنا .
فإن رأيت شرطيا يقود رجلا الى السجن علينا ألا نجزم في أيهما المجرم. وان رأينا
رجلا مضجرا بدمه وآخر مخضوب اليدين فمن الحصافة ألاّ نُحتِّم في أيّهما القاتل
وأيّهما القتيل. وان سمعنا رجلاً ينشد وآخر يندب فلنصبر ريثما نتثبّت ايهما
الطَّروب.
لا يا أخي لا تستدلَّ على حقيقة امرئٍ بما بما بان منه، ولا تتّخذ قول امرئٍ
أو عملا من اعماله عنوانا لطويَّته. فربّ من تستجهله لثقل في لسانه و ركاكةٍ في
لهجته كان وجدانه منهجاً للفطن و قلبه مهبطاً للوحي . وربّ من تحتقره لدمامة في
وجهه وخساسة في عيشه كان في الارض هبةً من هبات السماء وفي النَّاس نفحة من نفحات
الله.
قد تزور قصراً وكوخاً
في يوم واحد، فتخرج من الأول متهيِّبا ومن الثاني مشفقاً، ولكن لو استطعت تمزيق ما
تحوكه حواسُّك من الظَّواهر لتقلص تهيُّبك وهبط إلى مستوى الأسف، وانبدلت شفقتك
وتصاعدت إلى مرتبة الإجلال .
وقد تلتقي بين صباحك
ومسائك رجلين فيخاطبك الأول وفي صوته أهازيجُ العاصفة وفي حركاته هول الجيش، أما
الثاني فيحدِّثك متخوِّفاً وجِلاً بصوت مرتعش وكلمات متقطعة، فتعزو العَزم و الشجاعة إلى الأوَّل، والوهْنَ والجبن إلى الثَّاني، غير انك لو رايتهما
وقد دعتهما الأيام إلى لقاء المصاعب، او الى الاستشهاد في سبيل مبدإٍ، لعلمت أن
الوقاحة المبهرجة ليست ببسالةٍ والخجل الصَّامت ليس بجبانة.
وقد تنظر من نافذة
منزلك فترى بين عابري الطّريق راهبة تسيرُ يميناً ومومساً تسير شمالاً؛ فتقول على
الفور: ما أنبل هذه وما أقبح تلك ! ولكنّك لو أغمضت عينيك
وأصغيت هنيهة لسمعت صوتا هامسا في الأثير قائلا: هذه تنشدني بالصَّلاة وتلك ترجوني بالألم، وفي كل منهما مظلّة لروحي.
وقد تطوف في الأرض
باحثاً عمّا تدعوه حضارة وارتقاء، فتدخل مدينة حضارية شاهقة القصور فخمة المعابد
رحبة الشَّوارع , والقوم فيها يتسارعون الى هنا وهناك فذا يخترق الأرض وذاك يحلق
في الفضاء، وذاك يمتشق البرق، وغيره يستجوب الهواء، وكلهم بملابس حسنة الهندام،
بديعة الطراز، و كأنهم في عيد أو مهرجان.
وبعد أيام يبلغ بك
المسير الى مدينة أخرى حقيرة المنازل ضيقة الأزقّة إذا أمطرتها السماء تحولت إلى
جزر من المدر في بحر من الأوحال. وان شخصت بها الشمس انقلبت إلى غيمة من الغبار.
أما سكانها فما برحوا بين الفطرة والبساطة كوتر مسترخ بين طرفي القوس. يسيرون
متباطئين ويعملون متماهلين وينظرون اليك كأن وراء عيونهم عيونا تحدق الى شيء بعيد
عنك، فترحل عن بلدهم ماقتاً مشمئزا قائلا في سرّك: إنما الفرق بين الحياة
والاحتضار. فهناك القوة بمدّه وهنا الضعف بجزره. هناك الجد ربيعٌ وصيفٌ وهنا
الخمول خريف وشتاء. هناك اللّجاجة شبابٌ يرقُصُ في بستانٍ وهنا الوهن شيخوخة
مستلقية على الرَّماد.
ولكن لو استطعت النَّظر بنور الله إلى المدينتين لرأيتهما شجرتين متجانستين في
حديقةٍ واحدةٍ. وقد يمتدُّ بك التّبصُّر في حقيقتهما فترى إن ما توهَّمته رقيّاً
في احداهما لم يكن سوى فقاقيع لماعة زائلة. وما حسبته خمولاً في الأخرى كان جوهرا
خفيّاً ثابتاً.
لا ليست الحياة بسُطُوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا
النَّاس بوجوههم بل بقلوبهم.
لا ولا الدينُ بما تُظهره المعابد وتبنيه الطُّقوس والتقاليد، بل بما يَختبِئُ
في النُّفوس و يتجوهر بالنِّيّات.
لا ولا الفنُّ بما تسمعُهُ
بأُذُنيك من نبرات و خفضات أُغنية، أو من رنّات أجراس الكلام في قصيدة، أو بما
تبصره بعينيك من خطوط وألوان صورة. بل الفنُّ بتلك
المسافات الصَّامتة المرتعشة التي تجيء بين النَّبرات والخفضات في الأغنية. وبما
يتسرّب إليك بواسطة القصيدة مما بقي ساكتاً هادئاً مستوحشاً في روح الشَّاعر، وبما
تُوحيه إليك الصُّورة فترى وأنت محدِّقٌ إليها ما هو ابعد وأجمل منها.
لا يا أخي , ليست
الأيَّام والليالي بظواهرها. وأنا، أنا السَّائر في موكب الأيام واللَّيالي، لست
بهذا الكلام الذي اطرحه عليك إلا ّ بقدر ما يحمله إليك الكلام من طويتي السّاكنة.
إذا لا تحسبني جاهلاً قبل أن تفحص ذاتي الخفيّة، ولا تتوهمني عبقريًّا قبل أن
تجردني من ذاتي المقتبسة. لا تقل هو بخيلٌ قابض الكفّ قبل أن ترى قلبي، أو هو
الكريم الجواد قبل أن تعرف الواعز إلى كرمي وجودي . لا تدعني محبًّا حتى يتجلّى
حبي بكلّ ما فيه من النُّور والنَّار، ولا تعدني خليًّا قبل
أن تلمس جراحي الدَّاميّة.
كتاب [البدائع والطرائف] .
*****
______________________________________________________________________________________________
قدر ، عقوبة ، امتحان ...
لـ د . أحمد خيري العمري
كيف نفرق بين ما هو (قدر (قدّره الله علينا ، وبين (عقوبة) ربانية
نزلت بنا؟
جاءني هذا السؤال من أحد الأخوة.
ويقصد الأخ بتفصيل أكثر : كيف نعرف مثلا ، أن خسارته لعمله ، أو تعرضه للفصل من العمل ، كان (عقوبة) دنيوية من الله على خطأ فعله ، أو أنه كان مقدرا من قبل أن يرتكب الخطأ ؟
السؤال منطقي جدا ، ولكن منطقيته نابعة من عدم وضوح (أو عدم منطقية) المفهوم السائد للقدر ، وإشكالية ( كيف يعذبنا بذنب قدره علينا ..الخ) الشهيرة التي تعتبر من كلاسيكيات الجدال في الموضوع.
في حياة الإنسان ، أمور قدرية خالصة لا مجال لتغييرها (للأسف) ، نحن نولد في فترة زمنية معينة ، في بيئة جغرافية محددة ، ولأبوين محددين ينتميان بدورهما لطبقة اجتماعية محددة ، هذه الأمور (قدرية) وهي تملك مبدئيا تأثيرا كبيرا على مسيرة حياتنا لاحقا ، فالفترة الزمنية يكون لها قيمها وظروفها وتطلعاتها ، والبيئة الجغرافية (مثل البلد الذي ولدت فيه وثقافته وقيمه ) يكون له أيضا تأثير كبير على ما تأخذه منه ( من يولد في زمن الحرب ووبلد الحرب ليس كمن يولد في بلد لم تعرف الحرب لخمسين عاما) ، وبالتأكيد تأخذ من أبويك الكثير ، على الصعيد الجيني الوراثي ، وعلى صعيد التربية والقيم والطبيعة الشخصية لكل منهما ( وتفاعلك السلبي أو الإيجابي مع هذه الطبيعة).
كل هذه الأمور تحدث دون أن يكون لنا أي وعي أو إرادة أو قدرة على تغييرها.
هذا قدر محض.
لقد اختار الله لك هذه البوتقة ( الأبوين -الزمان- المكان) التي ولدت فيها.
لكن ما يلي ذلك ، خصوصا بعد أن يبدأ وعيك بالتشكل والتكون ، لا يشبه ما سبقعلى الإطلاق.
صحيح أن وعيك الشخصي وإدراكك سيتأثران بما سبق ، لكن الأمر يبقى يحتمل وجود هامش واسع من الاختيار.
في الكثير من خطوات حياتنا اللاحقة للمرحلة المبكرة ، هناك مفترقات طرق وتقاطعات متشابكة ، تستطيع أن تأخذ قرارا في الاتجاه الذي ستأخذه.
طريق حياتنا في البداية يكون مثل سكة حديد يسير عليها قطار بلا توقف في أي محطات ، هذا في البداية فقط ، لكن لاحقا الأمر أشبه بالمترو الذي يمكنك فيه أن تنزل في المحطة القادمة وتأخذ مترو يسير ياتجاه مختلف تماما وأحيانا معاكس تماما.
هنا سيكون السؤال الخالد : أليس كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ ؟
وهنا أيضا اللبس وسوء الفهم (المؤسف ) الحاصل .
علم الله المسبق بكل شيء ، ووجود ذلك في كتاب علمه ، لا يعني أننا مجبرون على ما نفعل كروبوت مبرمج على الفعل دون إرادة.
علم الله المسبق بأفعالنا له علاقة بقدرته الكلية المطلقة على العلم ، وليس بكوننا مجبرين على الفعل.
مثال للتقريب رغم حساسيته الشديدة لبعض الأخوة.
المعلم الذي خبر مستوى تلاميذه وقدراتهم واجتهادهم طيلة السنة الدراسية ، سيعلم (بشكل عام) كيف سيكون الأداء الذي سيقدمونه في اختبارات نهاية السنة.
نقول هذا ونقول أيضا ولله المثل الأعلى.
إذا كان المعلم ( بقدراته المحدودة بشريا ) قد تمكن من معرفة أداء مستقبلي لطلابه ، ولو بشكل تقريبي ، فألا يكون الله ، كلي القدرة ، كلي العلم ، قادرا على معرفة (خيارات) عباده مسبقا ؟ ودون أن يعني ذلك أنه يجبرهم على شيء ، بالضبط كما لم يجبر المعلم طلابه على شيء ، ولله المثل الأعلى مجددا.
هذا العلم المسبق المكتوب ، لا يعني أبدا أننا مجبرون على ما سنفعل ..مرة أخرى نضرب مثلا ولله المثل الأعلى : أولئك الذين يصدقون بالأبراج وقراءة الطالع وما إلى ذلك ، هل يعتقدون أن (المنجم) يجبرهم على شيء ما ؟ قطعا لا ، هم يحاولون التلصص على الغيب - المستقبل فحسب ، بعبارة أخرى هم يريدون معرفة محطات المترو القادمة في حياتهم ، وخياراتهم فيها.
سيأتي هنا موضوع (خلق أفعال العباد) المستمر بنجاح ساحق لأكثر من عشر قرون ، وستستدعى آية لا علاقة لها بالموضوع لحشرها في الجدل ، الآية هي (والله خلقكم وما تعملون) ، والآية لو قرأت في سياقها لكانت واضحة جدا ، الآيات التي سبقت تتحدث عن تحطيم سيدنا إبراهيم للأوثان ، وقوله لقومه (أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون) ، فمن الواضح جدا أنه لا يمكن لإبراهيم أن يعاتب قومه على عبادتهم لما ينحتون ، ثم ينسب فعلهم هذا لله مباشرة ، السياق هو بالتأكيد عن أن الله خلق المواد الأولية التي منها (تنحتون – تعملون) الأوثان. لا علاقة أبدا لكون أفعالنا مخلوقة من قبله عز وجل ، هي (معلومة) له قطعا ، ولكنه ترك لنا الخيار في فعلها بعد أن منحنا أدوات الإدراك والوعي (ألم نجعل له عينين.ولسنا وشفتين.وهديناه النجدين).
بالتأكيد هناك أمور لا نختارها : هناك حوادث شخصية لا نكون مسؤولين عنها بقدر ما نتعرض لها، هناك كوارث تصيب البلدان فتعم على الجميع، هناك أمراض ، وهناك أيضا الموت.هذا كله قدر لا خيار لنا فيه ، وإن كان لنا خيار في التصرف تجاهه (باستثناء الموت ، لا خيار !).
نعود الآن إلى سؤال الأخ بعد هذه الدورة الطويلة..
كيف يمكن أن نميز بين ما هو (قدر) وبين ما هو (عقوبة)؟
إن كنت تقصد بالقدر الأمر الحتمي الذي لا خيار لك فيه ، مثل ولادتك وأبويك وبلدك ، فهذا قدر ومن الصعب اعتباره عقوبة "حسنا، البعض سيعتبر أبويه أو بلده عقوبة ، لا بأس ، يمكن اعتبارهم امتحان ، هذا أكثر جدوى "
أما إن كنت تتحدث عن أمور أخرى ، مثل مشاكلك مع رئيس عملك أو تعرضك لتجربة شخصية فاشلة ومؤلمة فالأمر مختلف بقدر تحملك لمسؤولية مآلات الأمر.
الأمر هنا لا يتعلق بالحدث نفسه بقدر تعلقه بقراءتنا له ..
هل سنتحمل مسؤولية ما حدث تماما ؟ هل كانت النتيجة السيئة محصلة حتمية لأفعال سيئة قمنا بها ؟ يمكنك أن تقرأها إذن على أنها عقوبة ، وأنها
جاءت لتجعلك ترتدع عما فعلت (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون). لماذا لا يحدث هذا مع الجميع الذين يقومون بنفس الأفعال الخاطئة؟ ليس شأنك. لا تعرف مالذي يحدث للجميع في حياتهم الخاصة.ولا تعرف ماذا حدث لهم سابقا أو سيحدث لاحقا.
هل كنت مظلوما تماما فيما حدث؟ هل ظلمك رئيسك في العمل لأي سبب لا علاقة له بالعمل ؟ يحدث هذا . هذا اختبار وفرصة لك لكي تغير (محطة الميترو) في التوقف القادم. هل هناك أخطاء في حياتك الخاصة لا علاقة لها بالعمل وترى أن الله قد يعاقبك عليها ؟ صححها إذن بغض النظر عن السبب. التصحيح دوما جيد.
هل كان الخطأ في التجربة الشخصية يعود إلى الطرف الآخر ، هل كان اختيارك خاطئا ؟ تحمل المسؤولية إذن ، عقوبة على الخيار الخطأ ودرس للخيار اللاحق ، هل خدعك الطرف الآخر حقا بمعسول الكلام وحسن المظهر وصدقته ووثقت به أم أنك كنت تغض البصر عن عيوب واضحة ؟ عقوبة إذن على السذاجة أو على غض البصر ، ودرس لتجنب الإثنين في التجربة القادمة.
هل تعتبر أن بعض ضعفك أمر قدري لا فرار منه ، وأنك (ولدت هكذا) ولا خيار لك فيما تعمل من معاصي ، محض قدر ، استمر بالنواح إذن ، سيكون لديك المتسع من الوقت في الآخرة لذلك.
الأمر هو (كيف) تقرأ ما يحدث لك في حياتك . وليس (لماذا) يحدث ما يحدث.
في كل حدث ، هناك مفترقات طرق للفهم ، خيارات للفهم ، كما هناك مفترقات طرق للفعل وخيارات للفعل ، هناك ايضا خيارات لقراءة ما يحدث لك.
ما هو الصحيح في هذه القراءة؟
القراءة الصحيحة دوما هي التي تجعلك تصحح مسارك.
عقوبة.درس.امتحان....وكلها تدخل في علم الله المسبق الذي يعلم خياراتنا.
أما القدر بالمعنى الحتمي الذي لا فكاك منه : فهو محدد ومعروف..
ونادرا ما يمكن استخدامه (حقا) كشماعة.
رغم أنه الاستخدام الأكثر شيوعا ، للأسف.
جاءني هذا السؤال من أحد الأخوة.
ويقصد الأخ بتفصيل أكثر : كيف نعرف مثلا ، أن خسارته لعمله ، أو تعرضه للفصل من العمل ، كان (عقوبة) دنيوية من الله على خطأ فعله ، أو أنه كان مقدرا من قبل أن يرتكب الخطأ ؟
السؤال منطقي جدا ، ولكن منطقيته نابعة من عدم وضوح (أو عدم منطقية) المفهوم السائد للقدر ، وإشكالية ( كيف يعذبنا بذنب قدره علينا ..الخ) الشهيرة التي تعتبر من كلاسيكيات الجدال في الموضوع.
في حياة الإنسان ، أمور قدرية خالصة لا مجال لتغييرها (للأسف) ، نحن نولد في فترة زمنية معينة ، في بيئة جغرافية محددة ، ولأبوين محددين ينتميان بدورهما لطبقة اجتماعية محددة ، هذه الأمور (قدرية) وهي تملك مبدئيا تأثيرا كبيرا على مسيرة حياتنا لاحقا ، فالفترة الزمنية يكون لها قيمها وظروفها وتطلعاتها ، والبيئة الجغرافية (مثل البلد الذي ولدت فيه وثقافته وقيمه ) يكون له أيضا تأثير كبير على ما تأخذه منه ( من يولد في زمن الحرب ووبلد الحرب ليس كمن يولد في بلد لم تعرف الحرب لخمسين عاما) ، وبالتأكيد تأخذ من أبويك الكثير ، على الصعيد الجيني الوراثي ، وعلى صعيد التربية والقيم والطبيعة الشخصية لكل منهما ( وتفاعلك السلبي أو الإيجابي مع هذه الطبيعة).
كل هذه الأمور تحدث دون أن يكون لنا أي وعي أو إرادة أو قدرة على تغييرها.
هذا قدر محض.
لقد اختار الله لك هذه البوتقة ( الأبوين -الزمان- المكان) التي ولدت فيها.
لكن ما يلي ذلك ، خصوصا بعد أن يبدأ وعيك بالتشكل والتكون ، لا يشبه ما سبقعلى الإطلاق.
صحيح أن وعيك الشخصي وإدراكك سيتأثران بما سبق ، لكن الأمر يبقى يحتمل وجود هامش واسع من الاختيار.
في الكثير من خطوات حياتنا اللاحقة للمرحلة المبكرة ، هناك مفترقات طرق وتقاطعات متشابكة ، تستطيع أن تأخذ قرارا في الاتجاه الذي ستأخذه.
طريق حياتنا في البداية يكون مثل سكة حديد يسير عليها قطار بلا توقف في أي محطات ، هذا في البداية فقط ، لكن لاحقا الأمر أشبه بالمترو الذي يمكنك فيه أن تنزل في المحطة القادمة وتأخذ مترو يسير ياتجاه مختلف تماما وأحيانا معاكس تماما.
هنا سيكون السؤال الخالد : أليس كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ ؟
وهنا أيضا اللبس وسوء الفهم (المؤسف ) الحاصل .
علم الله المسبق بكل شيء ، ووجود ذلك في كتاب علمه ، لا يعني أننا مجبرون على ما نفعل كروبوت مبرمج على الفعل دون إرادة.
علم الله المسبق بأفعالنا له علاقة بقدرته الكلية المطلقة على العلم ، وليس بكوننا مجبرين على الفعل.
مثال للتقريب رغم حساسيته الشديدة لبعض الأخوة.
المعلم الذي خبر مستوى تلاميذه وقدراتهم واجتهادهم طيلة السنة الدراسية ، سيعلم (بشكل عام) كيف سيكون الأداء الذي سيقدمونه في اختبارات نهاية السنة.
نقول هذا ونقول أيضا ولله المثل الأعلى.
إذا كان المعلم ( بقدراته المحدودة بشريا ) قد تمكن من معرفة أداء مستقبلي لطلابه ، ولو بشكل تقريبي ، فألا يكون الله ، كلي القدرة ، كلي العلم ، قادرا على معرفة (خيارات) عباده مسبقا ؟ ودون أن يعني ذلك أنه يجبرهم على شيء ، بالضبط كما لم يجبر المعلم طلابه على شيء ، ولله المثل الأعلى مجددا.
هذا العلم المسبق المكتوب ، لا يعني أبدا أننا مجبرون على ما سنفعل ..مرة أخرى نضرب مثلا ولله المثل الأعلى : أولئك الذين يصدقون بالأبراج وقراءة الطالع وما إلى ذلك ، هل يعتقدون أن (المنجم) يجبرهم على شيء ما ؟ قطعا لا ، هم يحاولون التلصص على الغيب - المستقبل فحسب ، بعبارة أخرى هم يريدون معرفة محطات المترو القادمة في حياتهم ، وخياراتهم فيها.
سيأتي هنا موضوع (خلق أفعال العباد) المستمر بنجاح ساحق لأكثر من عشر قرون ، وستستدعى آية لا علاقة لها بالموضوع لحشرها في الجدل ، الآية هي (والله خلقكم وما تعملون) ، والآية لو قرأت في سياقها لكانت واضحة جدا ، الآيات التي سبقت تتحدث عن تحطيم سيدنا إبراهيم للأوثان ، وقوله لقومه (أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون) ، فمن الواضح جدا أنه لا يمكن لإبراهيم أن يعاتب قومه على عبادتهم لما ينحتون ، ثم ينسب فعلهم هذا لله مباشرة ، السياق هو بالتأكيد عن أن الله خلق المواد الأولية التي منها (تنحتون – تعملون) الأوثان. لا علاقة أبدا لكون أفعالنا مخلوقة من قبله عز وجل ، هي (معلومة) له قطعا ، ولكنه ترك لنا الخيار في فعلها بعد أن منحنا أدوات الإدراك والوعي (ألم نجعل له عينين.ولسنا وشفتين.وهديناه النجدين).
بالتأكيد هناك أمور لا نختارها : هناك حوادث شخصية لا نكون مسؤولين عنها بقدر ما نتعرض لها، هناك كوارث تصيب البلدان فتعم على الجميع، هناك أمراض ، وهناك أيضا الموت.هذا كله قدر لا خيار لنا فيه ، وإن كان لنا خيار في التصرف تجاهه (باستثناء الموت ، لا خيار !).
نعود الآن إلى سؤال الأخ بعد هذه الدورة الطويلة..
كيف يمكن أن نميز بين ما هو (قدر) وبين ما هو (عقوبة)؟
إن كنت تقصد بالقدر الأمر الحتمي الذي لا خيار لك فيه ، مثل ولادتك وأبويك وبلدك ، فهذا قدر ومن الصعب اعتباره عقوبة "حسنا، البعض سيعتبر أبويه أو بلده عقوبة ، لا بأس ، يمكن اعتبارهم امتحان ، هذا أكثر جدوى "
أما إن كنت تتحدث عن أمور أخرى ، مثل مشاكلك مع رئيس عملك أو تعرضك لتجربة شخصية فاشلة ومؤلمة فالأمر مختلف بقدر تحملك لمسؤولية مآلات الأمر.
الأمر هنا لا يتعلق بالحدث نفسه بقدر تعلقه بقراءتنا له ..
هل سنتحمل مسؤولية ما حدث تماما ؟ هل كانت النتيجة السيئة محصلة حتمية لأفعال سيئة قمنا بها ؟ يمكنك أن تقرأها إذن على أنها عقوبة ، وأنها
جاءت لتجعلك ترتدع عما فعلت (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون). لماذا لا يحدث هذا مع الجميع الذين يقومون بنفس الأفعال الخاطئة؟ ليس شأنك. لا تعرف مالذي يحدث للجميع في حياتهم الخاصة.ولا تعرف ماذا حدث لهم سابقا أو سيحدث لاحقا.
هل كنت مظلوما تماما فيما حدث؟ هل ظلمك رئيسك في العمل لأي سبب لا علاقة له بالعمل ؟ يحدث هذا . هذا اختبار وفرصة لك لكي تغير (محطة الميترو) في التوقف القادم. هل هناك أخطاء في حياتك الخاصة لا علاقة لها بالعمل وترى أن الله قد يعاقبك عليها ؟ صححها إذن بغض النظر عن السبب. التصحيح دوما جيد.
هل كان الخطأ في التجربة الشخصية يعود إلى الطرف الآخر ، هل كان اختيارك خاطئا ؟ تحمل المسؤولية إذن ، عقوبة على الخيار الخطأ ودرس للخيار اللاحق ، هل خدعك الطرف الآخر حقا بمعسول الكلام وحسن المظهر وصدقته ووثقت به أم أنك كنت تغض البصر عن عيوب واضحة ؟ عقوبة إذن على السذاجة أو على غض البصر ، ودرس لتجنب الإثنين في التجربة القادمة.
هل تعتبر أن بعض ضعفك أمر قدري لا فرار منه ، وأنك (ولدت هكذا) ولا خيار لك فيما تعمل من معاصي ، محض قدر ، استمر بالنواح إذن ، سيكون لديك المتسع من الوقت في الآخرة لذلك.
الأمر هو (كيف) تقرأ ما يحدث لك في حياتك . وليس (لماذا) يحدث ما يحدث.
في كل حدث ، هناك مفترقات طرق للفهم ، خيارات للفهم ، كما هناك مفترقات طرق للفعل وخيارات للفعل ، هناك ايضا خيارات لقراءة ما يحدث لك.
ما هو الصحيح في هذه القراءة؟
القراءة الصحيحة دوما هي التي تجعلك تصحح مسارك.
عقوبة.درس.امتحان....وكلها تدخل في علم الله المسبق الذي يعلم خياراتنا.
أما القدر بالمعنى الحتمي الذي لا فكاك منه : فهو محدد ومعروف..
ونادرا ما يمكن استخدامه (حقا) كشماعة.
رغم أنه الاستخدام الأكثر شيوعا ، للأسف.
*****
______________________________________________________________________________________________
مخيّر أم مسيّر ؟
لـ الدكتور مصطفى محمود
يسألني القراء دائما في استغراب.. كيف وصلت إلى قرارك الذي تردده في كل كتبك و مقالاتك بأن الإنسان مخير لا مسير.
كيف يكون الإنسان مخيرا و هو محكوم عليه بالميلاد و الموت و الاسم و الأسرة و البيئة، و لا حول له و لا قوة، و لا اختيار في هذه الأشياء التي تشكل له شخصيته و تصرفاته.
و القراء يقعون في خطأ أولي منذ البداية حينما يقيمون علاقة حتمية بين البيئة و السلوك.. و بين الأسرة و تقاليدها و بين الشخصية، و هو تفكير خاطئ، فلا توجد حتمية في الأمور الإنسانية.. و إنما يوجد – على الأكثر – ترجيح و احتمال و هذا هو الفرق بين الإنسان و الجماد و هذا هو الفرق بين الإنسان و برادة الحديد.
برادة الحديد تطاوع خطوط المجال المغناطيسي في حتمية و جبرية و تراص في خطوط المجال حتما حينما نرشها حول المغناطيس.
أما الإنسان فإن علاقته بظروفه لا تزيد على كونها احتمالا أو ترجيحا.
الابن الذي ينشأ في عائلة محافظة محتمل أن ينشأ محافظا هو الآخر مجرد احتمال.. و كثيرا ما يحدث العكس، فنرى هذا الابن و قد انقلب متمردا ثائرا على التقاليد، محطما لها..
و هذا هو الفرق بين المسائل الآلية الميكانيكية و المسائل الإنسانية.. و نفس الكلام يقال في البيئة..
البيئة تشكل الإنسان.. و لكن الإنسان أيضا يشكل البيئة.
و نظرة سريعة في المجتمع العصري حولنا سوف ترينا كيف أخضع الإنسان مشاكل الحر و البرد و المسافات بعقله و علمه و استطاع أن يسودها فهو يكيف الهواء بالمكيفات، و هو يهزم المسافات بالمواصلات السريعة و البرق و الهاتف.
الإنسان ليس كتلة هلامية سلبية تشكلها حتميات البيئة.. و لكنه إرادة صلبة في ذاتها لها حريتها في توجيه الأحداث.
و هذا هو الإنسان الذي ولد طفلا تحكمه أسرته و بيئته و مقتضيات اسمه و تقاليده.. ها هو ذا يهاجر و يغير اسمه و بيئته و أسرته و ينتقل إلى مجتمع جديد فيصنع انقلابا في هذا المجتمع الجديد و يغيره من أساسه.
و ها هو ذا يموت فيترك كتابا.. فإذا بالكتاب يغير التاريخ.
و صحيح أن الإنسان قليل الحيلة في الطريقة التي يولد بها و في الطريقة التي يموت بها.. و لكنه بين ميلاده و موته يصنع حضارة.. أعطاه الله القدرة على أن يبني و يهدم و يحرر و يتحرر و يفكر و يبتكر و يخترع و يفجر و يعمر و يدمر.. و سلمه مقاليد الخير و الشر و حرية الاختيار.
و حواجز البيئة و ضغوط الظروف لا تقوم دليلا على عدم الحرية بل هي على العكس دليل على وجود هذه الحرية.. فلا معنى للحرية في عالم بلا عقبات.. و في مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الإنسان حرا، إذ لا توجد لرغباته مقاومات يشعر بحريته من خلال التغلب عليها.
و الحرية لا تعبر عن نفسها إلا من خلال العقبات التي تتغلب عليها.. فهي تكشف عن نفسها بصورة جدلية من خلال الفعل و مقاومة الفعل.
و لهذا كانت الضغوط و العوائق و العقبات من أدلة الحرية و ليس العكس.
و الفيلسوف الغزالي يحل المشكلة بأن يقول إن الله حر مخير مطلق التخيير و المادة الجامدة مسيرة منتهى التسيير.. و الإنسان في منزلة بين المنزلتين.. أي أنه مخير مسير في ذات الوقت.. مخير بمقدار مسير بمقدار.
و توضيحا لكلامه أقول إن الإنسان حر مطلق الحرية في منطقة ضميره.. في منطقة السريرة و النية.. فأنت تستطيع أن تجبر خادمك على أن يهتف باسمك أو يقبل يدك، و لكنك لا تستطيع أن تجبره على أن يحبك.. فمنطقة الحب و الكراهية و هي منطقة السريرة منطقة حرة حررها الله من كل القيود و رفع عنها الحصار و وضع جنده خارجها..
لا يدخل الشيطان قلبك إلا إذا دعوته أنت و فتحت له الباب.
و قد أراد الله هذه النية حرة لأنها مناط المسئولية و المحاسبة.
أما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فيها التدخل الإلهي عن طريق الظروف و الأسباب و الملابسات ليجعل الله أمرا ما ميسرا أو معسرا حسب نية صاحبه.
(( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) )) (الليل)
يمهد الله أسباب الشر للأشرار.. و يمهد أسباب الخير للأخيار.. ليخرج كل منا ما يكتمه و يفصح عن سريرته و نيته و يتلبس بفعله.
و بهذا لا يكون التسيير الإلهي منافيا أو مناقضا للتخيير، فالله يستدرج الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما يكتمه و يفصح عن نيته و دخيلته و يتلبس باختياره.
الله بإرادته يفضح إرادتنا و اختيارنا و يكشفنا أمام أنفسنا.
و من ثم يكون الإنسان في كتاب الله مخيرا مسيرا في ذات الوقت.. دون تناقض.. فالله يريد لنا و يقدر لنا حتى نكتب على أنفسنا ما نريده لأنفسنا و ما نخفيه في قلوبنا و ما نختاره في أعمق الأعماق دون جبر أو إكراه، و إنما استدراجا من خلال الأسباب و الظروف و الملابسات.
و في إمكان الواحد منا أن يبلغ ذروة الحرية بأن تكون إرادته هي إرادة الله و اختياره هو اختيار الله و عمله هو أمر الله و شريعته.. بأن يكون العبد الرباني الذي حياته هي الناموس الإلهي، فيعبد الله حبا و اختيارا لا تكليفا.. إنه الحب الذي قال عنه المسيح:
(( لو كان في قلبك ذرة ايمان و قلت للجبل انتقل من مكانك لانتقل من مكانه)).
كما يحدث أن نعطي من ذات نفوسنا لمن نحب كذلك يعطي الله من ذاته لأحبابه، فيحقق لهم ما يشاءون فيكونون الأحرار حقا .
يسألني القراء دائما في استغراب.. كيف وصلت إلى قرارك الذي تردده في كل كتبك و مقالاتك بأن الإنسان مخير لا مسير.
كيف يكون الإنسان مخيرا و هو محكوم عليه بالميلاد و الموت و الاسم و الأسرة و البيئة، و لا حول له و لا قوة، و لا اختيار في هذه الأشياء التي تشكل له شخصيته و تصرفاته.
و القراء يقعون في خطأ أولي منذ البداية حينما يقيمون علاقة حتمية بين البيئة و السلوك.. و بين الأسرة و تقاليدها و بين الشخصية، و هو تفكير خاطئ، فلا توجد حتمية في الأمور الإنسانية.. و إنما يوجد – على الأكثر – ترجيح و احتمال و هذا هو الفرق بين الإنسان و الجماد و هذا هو الفرق بين الإنسان و برادة الحديد.
برادة الحديد تطاوع خطوط المجال المغناطيسي في حتمية و جبرية و تراص في خطوط المجال حتما حينما نرشها حول المغناطيس.
أما الإنسان فإن علاقته بظروفه لا تزيد على كونها احتمالا أو ترجيحا.
الابن الذي ينشأ في عائلة محافظة محتمل أن ينشأ محافظا هو الآخر مجرد احتمال.. و كثيرا ما يحدث العكس، فنرى هذا الابن و قد انقلب متمردا ثائرا على التقاليد، محطما لها..
و هذا هو الفرق بين المسائل الآلية الميكانيكية و المسائل الإنسانية.. و نفس الكلام يقال في البيئة..
البيئة تشكل الإنسان.. و لكن الإنسان أيضا يشكل البيئة.
و نظرة سريعة في المجتمع العصري حولنا سوف ترينا كيف أخضع الإنسان مشاكل الحر و البرد و المسافات بعقله و علمه و استطاع أن يسودها فهو يكيف الهواء بالمكيفات، و هو يهزم المسافات بالمواصلات السريعة و البرق و الهاتف.
الإنسان ليس كتلة هلامية سلبية تشكلها حتميات البيئة.. و لكنه إرادة صلبة في ذاتها لها حريتها في توجيه الأحداث.
و هذا هو الإنسان الذي ولد طفلا تحكمه أسرته و بيئته و مقتضيات اسمه و تقاليده.. ها هو ذا يهاجر و يغير اسمه و بيئته و أسرته و ينتقل إلى مجتمع جديد فيصنع انقلابا في هذا المجتمع الجديد و يغيره من أساسه.
و ها هو ذا يموت فيترك كتابا.. فإذا بالكتاب يغير التاريخ.
و صحيح أن الإنسان قليل الحيلة في الطريقة التي يولد بها و في الطريقة التي يموت بها.. و لكنه بين ميلاده و موته يصنع حضارة.. أعطاه الله القدرة على أن يبني و يهدم و يحرر و يتحرر و يفكر و يبتكر و يخترع و يفجر و يعمر و يدمر.. و سلمه مقاليد الخير و الشر و حرية الاختيار.
و حواجز البيئة و ضغوط الظروف لا تقوم دليلا على عدم الحرية بل هي على العكس دليل على وجود هذه الحرية.. فلا معنى للحرية في عالم بلا عقبات.. و في مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الإنسان حرا، إذ لا توجد لرغباته مقاومات يشعر بحريته من خلال التغلب عليها.
و الحرية لا تعبر عن نفسها إلا من خلال العقبات التي تتغلب عليها.. فهي تكشف عن نفسها بصورة جدلية من خلال الفعل و مقاومة الفعل.
و لهذا كانت الضغوط و العوائق و العقبات من أدلة الحرية و ليس العكس.
و الفيلسوف الغزالي يحل المشكلة بأن يقول إن الله حر مخير مطلق التخيير و المادة الجامدة مسيرة منتهى التسيير.. و الإنسان في منزلة بين المنزلتين.. أي أنه مخير مسير في ذات الوقت.. مخير بمقدار مسير بمقدار.
و توضيحا لكلامه أقول إن الإنسان حر مطلق الحرية في منطقة ضميره.. في منطقة السريرة و النية.. فأنت تستطيع أن تجبر خادمك على أن يهتف باسمك أو يقبل يدك، و لكنك لا تستطيع أن تجبره على أن يحبك.. فمنطقة الحب و الكراهية و هي منطقة السريرة منطقة حرة حررها الله من كل القيود و رفع عنها الحصار و وضع جنده خارجها..
لا يدخل الشيطان قلبك إلا إذا دعوته أنت و فتحت له الباب.
و قد أراد الله هذه النية حرة لأنها مناط المسئولية و المحاسبة.
أما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فيها التدخل الإلهي عن طريق الظروف و الأسباب و الملابسات ليجعل الله أمرا ما ميسرا أو معسرا حسب نية صاحبه.
(( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) )) (الليل)
يمهد الله أسباب الشر للأشرار.. و يمهد أسباب الخير للأخيار.. ليخرج كل منا ما يكتمه و يفصح عن سريرته و نيته و يتلبس بفعله.
و بهذا لا يكون التسيير الإلهي منافيا أو مناقضا للتخيير، فالله يستدرج الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما يكتمه و يفصح عن نيته و دخيلته و يتلبس باختياره.
الله بإرادته يفضح إرادتنا و اختيارنا و يكشفنا أمام أنفسنا.
و من ثم يكون الإنسان في كتاب الله مخيرا مسيرا في ذات الوقت.. دون تناقض.. فالله يريد لنا و يقدر لنا حتى نكتب على أنفسنا ما نريده لأنفسنا و ما نخفيه في قلوبنا و ما نختاره في أعمق الأعماق دون جبر أو إكراه، و إنما استدراجا من خلال الأسباب و الظروف و الملابسات.
و في إمكان الواحد منا أن يبلغ ذروة الحرية بأن تكون إرادته هي إرادة الله و اختياره هو اختيار الله و عمله هو أمر الله و شريعته.. بأن يكون العبد الرباني الذي حياته هي الناموس الإلهي، فيعبد الله حبا و اختيارا لا تكليفا.. إنه الحب الذي قال عنه المسيح:
(( لو كان في قلبك ذرة ايمان و قلت للجبل انتقل من مكانك لانتقل من مكانه)).
كما يحدث أن نعطي من ذات نفوسنا لمن نحب كذلك يعطي الله من ذاته لأحبابه، فيحقق لهم ما يشاءون فيكونون الأحرار حقا .
*****
__________________________________________________________________________
التوبة كـ "قصة حب"
د.أحمد خيري العمري
كانت
التوبة مرتبطة في ذهني دوما بما يجعلها أشبه بفيلم رومانسي حالم...مليئة بالمشاعر
والعواطف الحارة ،والرحمة والتراحم ، وربما الدموع هنا وهناك..
كان ذلك مخالفا تماما لسورة التوبة ..التي سميت أيضا سورة القتال ، وسورة براءة ، وهي السورة الوحيدة التي نزلت دون "البسملة"..أي دون دون أن يقدم للآيات ذكر صفتي "الرحمن الرحيم".
..وبالتدريج فهمت!
فهمت أن هذا الفهم "الشاعري" للتوبة ليس حقيقيا ولا واقعيا البتة..
وان التوبة هي أقرب فعلا لفيلم حربي ،بالضبط أقرب لسياقات سورة التوبة.. سورة القتال ، سورة براءة..
تقرأ في سورة التوبة قصة حربك مع نفسك للخلاص من ذنوبها ومعاصيها ، تقرأ فيها ذلك الجهاد المر لخلاصك من أدرانك.غالبا ما تكون معركتك في داخلك..غالبا ما تكون سرية لا يعرف بها أحد خارج عالمك الداخلي. لكن عنفها وصخبها في داخلك لا يكون أقل من أي حرب أخرى تخوضها..
في سورة التوبة ، تقرأ قصة توبتك عندما تكون حقيقية..
في السورة سفر في صحراء بعيد ، وحر شديد..، وثمار آن أوان حصادها بعد انتظار....وهم يتركونها للمضي إلى القتال..
كذلك في التوبة، في توبتك..أنها دوما رحلة وعرة في المجاهل القصية من نفسك، في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة، وقد تركت خلفك معاص وذنوب تنكرت بثياب الملذات..
دوما هناك عهد من نفسك لنفسك بأن تكف، تمنحها المهلة تلو المهلة..وتمر"المهلة" في هدوء، وتفاجئك نفسك بالغدر بعد المهلة..تفاجئ بها تعود إلى المعصية بعد أن أجزلت الوعود والمواثيق.. ها هي تنكث بكل ما قدمت..وها هي تقترف ما قالت أنها لن تعود إليه تحديدا..
وها أنت في لحظة حاسمة أمام قرار حاسم:هل ستواجه نفسك ؟ هل ستحاربها مادامت قد انسلخت من مواثيقها..
وأنت تعلم أنه ليس "عرضا قريبا ولا سفرا قاصدا"..وأن الرحلة في مجاهل نفسك ليست بتلك السهولة..
وأنت تعلم أن "مواجهتك" لنفسك، حتى لو كانت بينك وبين نفسك فقط ودون أن يعلم بها إلا من خلق نفسك، هي امتحان لك..امتحان إن كان ما ركنت له أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله...
توبتك تضعك في مواجهة مع نفسك : هل أنت مستعد حقا لقتالها ؟ هل أنت مستعد حقا لقتل ما يجب قتله من نفسك حيث وجدت هذا الجزء؟ هل أنت مستعد لتحصر هذه الأجزاء التي تعيقك"وتقعد لها كل مرصد ؟..
هل أنت على استعداد لأن تعلن براءتك من بعض نفسك؟..
أم أنك ستبحث عن أعذار..عن التأجيل..عن التسويف..عن فتاوى من هنا وهناك..عن الاستئذان بعدم المواجهة الذي يشي بما لا تريد مواجهته من حقيقة إيمانك...
نعم..
التوبة حرب بين وبين نفسك..حرب ضارية..حرب تقول لك أحيانا أن قيامك بالشعائر قد لا يكون أكثر من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كان يقوم بها المشركون..أو أن ما تتبرع له من "أعمال خير" قد يكون في نهاية الأمر ليس سوى "مسجد ضرار.."..
التوبة لحظة مواجهة حادة.استئصال لما رسب في نفسك مما لم يعد هناك مجال للتعايش معه.وصولا إلى "ضرب الرقاب"..وصولا إلى ذلك الاستئصال النهائي لجذر المعصية الذي سيجعلك تولد من جديد..
نعم، درب صحراوي قاحل..
أو جبلي وعر..
ولا يمكنك أن تستأنس بأحد.معركة التوبة لها خصائص شديدة الفردية.أنت وربك الذي يعلم ما في داخلك.ربك الذي ستر عليك رغم كل مخاطراتك..
***********
وفي لحظة ما..
ستكون كفة المعركة قد بدت لغير صالحك..
وستضيق عليك الأرض بما رحبت..
وستقول لنفسك أنك خاسر لا محالة..وانك لن تنفذ قط من شرك المعصية واستعبادها لك..
ولكن، فجأة..
تتدفق التوبة من ثقب بحجم السماء في فضاءات روحك..
ولقد تاب الله عليك..
************
نعم.
فيلم حربي..
لكن لا يخلو من قصة حب..
كما في كل الأفلام !..
قصة حب مع من يستحقها . مع الحقيقة . مع نفسك كما يجب أن تكون..
مع من تاب عليها..
مع من يأخذ بيدك..
ومع من تأخذ بيده..
************
البعض يريد أن يتوب من "قصة حب"!..
والبعض الآخر ، يريد من توبته أن تكون عظيمة ، كقصة حب...
كان ذلك مخالفا تماما لسورة التوبة ..التي سميت أيضا سورة القتال ، وسورة براءة ، وهي السورة الوحيدة التي نزلت دون "البسملة"..أي دون دون أن يقدم للآيات ذكر صفتي "الرحمن الرحيم".
..وبالتدريج فهمت!
فهمت أن هذا الفهم "الشاعري" للتوبة ليس حقيقيا ولا واقعيا البتة..
وان التوبة هي أقرب فعلا لفيلم حربي ،بالضبط أقرب لسياقات سورة التوبة.. سورة القتال ، سورة براءة..
تقرأ في سورة التوبة قصة حربك مع نفسك للخلاص من ذنوبها ومعاصيها ، تقرأ فيها ذلك الجهاد المر لخلاصك من أدرانك.غالبا ما تكون معركتك في داخلك..غالبا ما تكون سرية لا يعرف بها أحد خارج عالمك الداخلي. لكن عنفها وصخبها في داخلك لا يكون أقل من أي حرب أخرى تخوضها..
في سورة التوبة ، تقرأ قصة توبتك عندما تكون حقيقية..
في السورة سفر في صحراء بعيد ، وحر شديد..، وثمار آن أوان حصادها بعد انتظار....وهم يتركونها للمضي إلى القتال..
كذلك في التوبة، في توبتك..أنها دوما رحلة وعرة في المجاهل القصية من نفسك، في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة، وقد تركت خلفك معاص وذنوب تنكرت بثياب الملذات..
دوما هناك عهد من نفسك لنفسك بأن تكف، تمنحها المهلة تلو المهلة..وتمر"المهلة" في هدوء، وتفاجئك نفسك بالغدر بعد المهلة..تفاجئ بها تعود إلى المعصية بعد أن أجزلت الوعود والمواثيق.. ها هي تنكث بكل ما قدمت..وها هي تقترف ما قالت أنها لن تعود إليه تحديدا..
وها أنت في لحظة حاسمة أمام قرار حاسم:هل ستواجه نفسك ؟ هل ستحاربها مادامت قد انسلخت من مواثيقها..
وأنت تعلم أنه ليس "عرضا قريبا ولا سفرا قاصدا"..وأن الرحلة في مجاهل نفسك ليست بتلك السهولة..
وأنت تعلم أن "مواجهتك" لنفسك، حتى لو كانت بينك وبين نفسك فقط ودون أن يعلم بها إلا من خلق نفسك، هي امتحان لك..امتحان إن كان ما ركنت له أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله...
توبتك تضعك في مواجهة مع نفسك : هل أنت مستعد حقا لقتالها ؟ هل أنت مستعد حقا لقتل ما يجب قتله من نفسك حيث وجدت هذا الجزء؟ هل أنت مستعد لتحصر هذه الأجزاء التي تعيقك"وتقعد لها كل مرصد ؟..
هل أنت على استعداد لأن تعلن براءتك من بعض نفسك؟..
أم أنك ستبحث عن أعذار..عن التأجيل..عن التسويف..عن فتاوى من هنا وهناك..عن الاستئذان بعدم المواجهة الذي يشي بما لا تريد مواجهته من حقيقة إيمانك...
نعم..
التوبة حرب بين وبين نفسك..حرب ضارية..حرب تقول لك أحيانا أن قيامك بالشعائر قد لا يكون أكثر من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كان يقوم بها المشركون..أو أن ما تتبرع له من "أعمال خير" قد يكون في نهاية الأمر ليس سوى "مسجد ضرار.."..
التوبة لحظة مواجهة حادة.استئصال لما رسب في نفسك مما لم يعد هناك مجال للتعايش معه.وصولا إلى "ضرب الرقاب"..وصولا إلى ذلك الاستئصال النهائي لجذر المعصية الذي سيجعلك تولد من جديد..
نعم، درب صحراوي قاحل..
أو جبلي وعر..
ولا يمكنك أن تستأنس بأحد.معركة التوبة لها خصائص شديدة الفردية.أنت وربك الذي يعلم ما في داخلك.ربك الذي ستر عليك رغم كل مخاطراتك..
***********
وفي لحظة ما..
ستكون كفة المعركة قد بدت لغير صالحك..
وستضيق عليك الأرض بما رحبت..
وستقول لنفسك أنك خاسر لا محالة..وانك لن تنفذ قط من شرك المعصية واستعبادها لك..
ولكن، فجأة..
تتدفق التوبة من ثقب بحجم السماء في فضاءات روحك..
ولقد تاب الله عليك..
************
نعم.
فيلم حربي..
لكن لا يخلو من قصة حب..
كما في كل الأفلام !..
قصة حب مع من يستحقها . مع الحقيقة . مع نفسك كما يجب أن تكون..
مع من تاب عليها..
مع من يأخذ بيدك..
ومع من تأخذ بيده..
************
البعض يريد أن يتوب من "قصة حب"!..
والبعض الآخر ، يريد من توبته أن تكون عظيمة ، كقصة حب...
*****
________________________________________________
الكهف: خطة لكل أسبوع قادم
لــ د. أحمد خيري العمري
البوصلة القرآنية
"سورة الكهف" في حقيقتها هي مثل مغارة علي بابا.. (ولله المثل الأعلى)...
تحوي كنوزا لا يمكن تخيل وجودها .. وكل مرة نعتقد أن الأمر
انتهى ، فإذا بها تقدم لنا المزيد ..
نقف أمامها ونقول "اقرأ"
.. فتنهمر بيادر السمسم والخير والعطاء..
كل القرآن هكذا بالتأكيد
..
لكن ارتباط سورة الكهف بالقراءة
الاسبوعية يجعلنا في مواجهة هذا العطاء مباشرة ..
سورة الكهف تفتح لنا باب
المغارة الأكبر...
أمام المنجم بأسره .. وفيه
ثروات خام لم تكتشف بعد..
خطة كل أسبوع :
· انسحاب وتأمل ومراجعة وإعادة تقييم.
· تحديد أولويات وثوابت.
· نزول للواقع لفهمه بناء على ما سبق.
· التنفيذ.
كانت هذه هي سورة الكهف :
· الفتية و الكهف.
· الحوار مع صاحب الجنتين.
· موسى والخضر.
· ذو القرنين.
1)
انسحاب وتأمل ومراجعة وإعادة تقييم
(الفتية والكهف)
تمر
الأفكار بمختلف أنواعها، بأطوار هي أشبه بأطوار الاستحالة، تلج فيها من عالم هو
أشبه بعالم العدم، ثم تنمو، وتزدهر، إلى أن تبلغ قمة نضجها واكتمالها..
يحدث
ذلك مع فكرة قد تكون فكرة مبدعة في رأس فنان مبدع، لكنه يطاردها، ثم يقتنصها،
يتقمصها، يصيرها، وتصيره، إلى أن يستطيع أن يجسد الفكرة، بعمل متكامل..
ويحدث
أيضاً مع النظريات العلمية، يبدأ الأمر بفكرة قد تكون غريبة ومرفوضة وخارجة عن
السرب، ثم تنمو، وتتطور، ومن طور إلى آخر، إذا بها قد صارت نظرية، سيكون لها
أعداؤها، وأيضاً مناصروها، ومع الوقت إذا بها تدحض أعداءَها، ربما لا تضمهم إلى
صفها بالضبط ولكنهم مع الوقت يقلون عدداً، ومن ثم تنجح لا في امتحان التطبيق فقط،
بل في امتحان “الزمن”..
كذلك
الأمر مع الإيديولوجيات والعقائد، تبدأ كفكرة قد يرفضها السائد والمتعارف عليه
اجتماعياً، فكرة منبوذة قد لا تثير غير الاستنكار، لكن مع الوقت، تتراكم حول
الفكرة الأفكار، وتتلاءم معها، ويزيد المؤمنون بها، بعضهم يقدم المزيد من الأفكار،
وآخرون قد يقدمون أكثر من الأفكار، قد يقدمون حياتهم – حرفياً – وأحياناً يقدمونها حتى بأعمق من تقديمها حرفياً..
وقد يتمكن ذلك التلاحم لاحقاً من إحداث ثغرة في جدار الواقع، وقد تكبر الثغرة
لتصير شرخاً، ومن الشرخ تتسرب الإيديولوجية لتتشرب في الواقع..
وليست
“فكرة النهضة” ببعيدة
عن هذا، إنها تمر أيضاً بمراحل وأطوار جزئية، قد يدوم بعضها دهوراً، وقد يدوم
بعضها الآخر ما هو أقل، إلى أن يحدث الظهور – الولادة..
مراحل
التشكل هذه ليست مرتبطة بقانون واضح يضعها في إطار وقالب، قد تتمدد وتتقلص بحسب
المحيط الأوسع، لكنها في مرحلة ما ستوثر في هذا المحيط، وسيصير ساحة لتفاعلها..
ونموها..
عن
مراحل التخلق والتشكل هذه، عن أطوار الاستحالة التي تمر بها الفكرة، تحدثنا سورة
الكهف، التي جرى العرف قراءتها كل جمعة، كما لو أنها تجعلنا نراقب هذا التشكل
أسبوعياً، كما لو أن هذه القراءة تجعلنا أيضاً نرعاه، نهتم بإنمائه وبتغذيته،
نحميه، نكون جزءاً منه، أو يكون هو جزءاً منا..
سورة
الكهف، بسياقها الأوسع، تجعلنا في خضم عملية تخلق واسع وممتدة، تجعلنا نتواصل مع
أطوار الاستحالة تلك، تضعنا في تماس معها على الرغم من أنها خارج الزمان والمكان،
لكن نقطة التماس هذه معنا تستحضر وتستفز عملية التخلق، تقدح شرارتها “افتراضياً
على الأقل” في أعماقنا..
يبدأ
الأمر من ذلك التعجب من التعجب: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا
مِنْ آياتِنا عَجَباً} [الكهف: 18/9] فليس العجيب هو طور واحد من هذه
الأطوار، ولكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو عملية التخلق ككل، هو هذا الانتقال
الذي يحدث من طور إلى آخر، عبر القرون وعبر القارات ومن قبل أشخاص قد لا تربطهم أي
رابطة مادية واضحة، غير رابطة المشاركة في أطوار الاستحالة..
سنراهم
أول شيء، أولئك الفتية الذين آمنوا بالفكرة، وستكون فتوتهم هنا رمزاً لشباب يكون
دوماً هو أول من يعتنق الفكرة الجديدة ويؤمن بها، ربما لأنه يكون قد تعرض لتدجين
أقل، ربما لأن هذا الجيل الجديد أكثر قدرة على رؤية الفساد والظلم في المجتمع
القائم، ربما لأنه لم يفسد بعد، ولم يتورط بعد، ولم يصبح جزءاً من هذا العالم،
ربما لأنهم لم يغتالوا الحلم فيه، لم يفقدوه إيمانه بقدرته على التغيير، لذلك
نراهم هناك، في ذلك الطور الأول، آمنوا بربهم فزادهم هدى، وكان الشرك هنا ليس مجرد
عقيدة فاسدة، بل كان منظومة واسعة من القيم والعلاقات الاجتماعية التي “الظلم” هو
سمتها الأساسية، وكان هؤلاء الفتية، يغردون خارج السرب الاجتماعي القائم، وكانت
منظومتهم الفكرية هي الأصدق والأكثر عدالة والأقرب إلى النسق الكوني، إلا أنها
كانت نشازاً ضمن ذلك الواقع المحيط.
وكما
كان شباب حاملي الفكرة سبباً في قوتها، فقد كان أيضاً سبباً في ضعفها من جانب آخر،
كان صغر سنهم سبباً في جعلهم يعتنقون الفكرة، لكنه كان سبباً أيضاً في رفض
المؤسسات القائمة لهم ولها، بلا دعم مؤسساتي، لم يكن لهم أن ينشروا فكرتهم، بل لم
يكن ممكناً لفكرتهم أن تصمد.
كانوا
يواجهون خطرين: إما الإزاحة المادية والإقصاء المعنوي الذي سيقوم به المجتمع
تجاههم، أو تذويبهم واحتواءهم بالتدريج، كانت “فكرتهم” وهي لا تزال جنينية غير
مؤهلة بعد للتفاعل، غير مؤهلة للصمود، وكان التفاعل المبكر قد يؤدي إلى إجهاضها
وقتلها أو قتلهم هم.. لذلك كان لا بد من خيار ثالث غير هذين، خيار يحافظ على
“الفكرة” – “الجنين” ويحميها من التفاعل المبكر ويمنحها الوقت اللازم للنمو، إلى
أن يأتي وقت التفاعل الأنسب الذي سيزيد الفكرة مناعة ورسوخاً.. هذا الخيار الثالث
هو “الاعتزال” {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهيِّئْ لَكُمْ مِنْ
أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً} [الكهف: 18/16] فلننتبه أنه لم يكن “العزلة”، بل كان
“الاعتزال”، والفرق بين الاثنين أن العزلة تكون حالة يفرضها المجتمع، حالة من
النبذ واللاتواصل تفرضها المؤسسات الاجتماعية من أجل خنق الفكرة المنبوذة
وحامليها، أما الاعتزال فهو عملية واعية يقوم بها من يتصور أن “الاختلاط” في
مرحلته الآنية، سيعرض الفكرة لمواجهة مبكرة قد تكون قاتلة، لذا فالاعتزال يمثل
فرصة نجاة محتملة لهذه الفكرة، وهو هنا، بالتأكيد، أعمق وأكبر بكثير من فرصة
للتعبد والترهبن، فالاعتزال هنا ليس انسحاباً زاهداً بالمجتمع، بل هو “تكتيك”
لمواجهة المجتمع، يتطلب انسحاباً مرحلياً.. دون أن ينسى إستراتيجيته الأساسية
الرامية لإعادة بناء المجتمع..
هذا
هو الكهف، تكتيك ضمن إستراتيجية أوسع، طور أولي من أطوار الاستحالة، تكون فيه
الفكرة جنيناً يحتاج إلى “الحاضنة” التي تزيده قوة ومناعة، الفكرة هنا ستكون خارج
التفاعل التاريخي، بل حتى خارج الزمان والمكان، فالكهف هو تلك “الفجوة” من الزمان والمكان التي تهيئ “الكمون” للفكرة،
و”الكمون” هنا استمر ثلاثة قرون وأكثر، وكان في جوهره المحافظة على”البذرة”،
بتهيئة الظروف التي تحافظ على حيويتها ونشاطها وصفاتها، بدلاً من تضييعها بزراعتها
في أرض غير خصبة، وظروف مناخية غير مناسبة قد تجهض البذرة والفكرة في آن..
كان
الاستثمار -ولو اللاحق- لتلك البذرة هو هم أولئك الشباب (الذين ظلوا شباباً لثلاثة
قرون) لذلك فهم يتواصون فيما بينهم {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً} [الكهف:
18/20] فالفلاح هنا هو الفلاح بالمعنى الأعمق والأوسع، وهو لا يقتصر على
الفلاح الأخروي أبداً، إذ إن النجاة الأخروية لن تتعارض مع “الرجم”، بل إن “الرجم”
سيكون أقرب الطرق إلى الفلاح الأخروي بالمعنى التقليدي السائد “حاليا!”، لكن لا،
ليس ذاك هو الذي في أذهانهم، إنهم يريدون “الفلاح” الشامل، رديف النهضة، حيث
الموقع الأخروي يتحقق عبر الموقع الدنيوي، إنهم يريدون الفلاح – أي فلاحة الأرض – عبر استخدام تلك البذرة التي اعتزلوا من أجل المحافظة عليها..
طور
الكمون طور حساس ومهم جداً.. ذلك أن أي إنهاء مبكر له، سيعرض فكرة النهضة برمتها
للإجهاض، وسيجعلها في سياق تفاعل غير متساوٍ، قد يحرف الفكرة عن مسارها.. وطور
الكمون قد يستمر لفترة طويلة، لقرون، كما حدث مع أولئك الفتية، لكن في لحظة ما،
ستحين “الفرصة التاريخية” التي تتيح للفكرة –البذرة أن تخرج من حاضنتها إلى حيث التربة والتفاعل مع
الواقع..
قد
تتمخض الفرصة التاريخية عند انهيار المؤسسات التقليدية بطريقة تجعل هذه الفكرة
أكثر قرباً، تصبح خياراً معقولاً أكثر، وقد تتمخض عن تصادم المؤسسات ببعضها إلى حد
الإنهاك، وقد تصبح، بشكل استثنائي، عندما تتبنى مؤسسة ما، لسبب أو لآخر، هذه
الفكرة..
الخروج
من الكمون، من الحاضنة التاريخية، إلى زمان الفعل ومكانه، خطوة مهمة وأساسية،
لكنها نهاية الطور الأول فقط.. والتحديات الأساسية لم تنته بعده..
والأمر
يشبه مخاض الولادة، الطفل ولد الآن، لكنه سيظل بحاجة إلى العناية والرعاية
والاهتمام.. سيحتاج إلى اللقاحات والتحصينات، والتغذية المتوازنة..
لكنه،
من هذه اللحظة فصاعداً: لم يعد جنيناً..
2)
تحديد أولويات وثوابت ( الحوار مع صاحب
الجنتين)
فكرة
النهضة التي تركناها في الحاضنة التاريخية، في كهف الكمون، انتظرت فترة طويلة حتى
تمكنت من الخروج لمواجهة الواقع، وبعد الخروج من الكهف، يأخذنا السياق إلى طور
الاستحالة الثاني، إلى صاحب الجنتين، وصاحبه، وذلك الحوار الذي تجاوز كل السياقات
التاريخية، ليكون صالحاً لكل زمان ومكان }: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لأَحَدِهِما
جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما
زَرْعاً(*) كِلْتا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً
وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً(*) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ
يُحاوِرُهُ أَنا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً(*) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ
لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً(*) وَما أَظُنُّ السّاعَةَ
قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً
(*) قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ
تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلاً(*) لَكِنّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي
وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (*) وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما
شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً
وَوَلَداً(*) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ
عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً(*) أَوْ يُصْبِحَ
ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً(*) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ
فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً(*) وَلَمْ
تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً]
{الكهف: 18/32-43].. سنلاحظ
هنا أنهما “رجلان” هنا، الرجل المؤمن، والرجل الكافر، أي إن الإيمان لم يعد ممثلاً
بفتية تمردوا على مكرسات
مجتمعهم، والتجؤوا إلى “كهف” ليكمن إيمانهم هناك، بل صار ممثلاً
في “رجل” مؤمن، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الإيمان هنا تجاوز مرحلة المشاعر التي
قد تغلب عليها العاطفة والحماس، ليصل إلى مرحلة أكثر نضوجاً تحتوي على هذه
المشاعر، ولكن تضم أيضاً
أبعاداً أخرى، تجعلها أكثر قوة، وتمكناً.
فلنلاحظ
هنا أيضاً، أن طور الاستحالة الثاني، الأكثر قوة وتمكناً، صار ممثلاً في فرد واحد،
وليس في مجموعة أفراد كما في الطور الأول، ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل مصادفةً،
لقد قلَّ “العدد” الممثل
للطور الثاني، لكن القوة ازدادت، وهذا ينفي فوراً فكرتنا
التقليدية عن “الكم”، لصالح “النوع”، فـ”الرجل” الذي مثل فكرة الإيمان والنهضة هنا، كان من “نوع” مرتفع
جداً، بحيث إن ذلك “عوَّض” عن
قلة العدد.. لم يكن الرجل هنا مجرد فرد عادي، مجرد مؤمن آخر، بل كان “رجلاً” حمل مسؤولية الحوار مع الفكرة المضادة،
لم يهرب من مواجهتها، ولم يذب فيها وفي انتصارها، كان رجلاً واحداً هنا، لكنه كان
يملك أرضية “الفكر” المستعد للصمود بوجه الفكر الآخر..
فلننتبه
هنا، أن السياق القرآني لا يضع الرجل المؤمن في موضع “الداعية” مع الرجل الكافر، فليسَ هو من بادر إلى الحوار، ولكن
الرجل الآخر، صاحب الجنتين، هو الذي ابتدأ} : وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ
وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} [الكهف:18/34 .[
وهذا
يجعلنا ننتبه إلى أن الحوار قد يفرض أحياناً من الجهة الأخرى، وليس بالضرورة البدء إلا عند تمام
الاستعداد لذلك، والأمر الثاني الأكثر أهمية هو أن “رجلنا” لم يرد
على الآخر عندما كان الحديث عن }أَنا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ
نَفَراً{، أي عندما كان يتحدث عن تفاصيل ثرائه وارتفاع مستوى دخله، ليس لأن
هذه التفاصيل كانت حقيقية فحسب، بل
لأن المقارنة هنا مجتزأة، وخارجة عن سياق تطور الفكرتين، فالكافر كان يعرض “ثمرة” نتاجه وهي في أوجها، بعد أن مرَّت بأطوار
وأدوار استحالتها الخاصة بها، وصولاً إلى “الثمر” الذي يباهي به، ناتجه من
تطور فكرته وتحقيقها على أرض الواقع، أما الرجل المؤمن، فلم يكن فكره أكثر من بذرة أخرجت تواً
من كهف كمونها، ولا تزال في مراحلها المبكرة.
المقارنة
هنا، هي مثل المقارنة بين رجل في مقتبل العمر، وجنين لم يولد بعد، الرجل حتماً
أكثر قوة وقدرة، ونجاحاً وثراء.. هو {أكثر مالاً وأعز نفراً} حتماً وبالتأكيد لأن
الجنين لم يأخذ فرصته بعد. المقارنة مرفوضة أصلاً، لأنها تجتزئ النتائج من السياق،
سنلاحظ لاحقاً، بروزاً من صاحب الجنتين ما يدل على كفره}: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ
لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (*) وَما أَظُنُّ
السّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها
مُنْقَلَباً} [الكهف: 36- . [18/ 35هنا سيكون
الحديث ليس عن الثمر،
والناتج، بل عن أصل البذرة، عن الفكرة الأصلية، عن الحجر الأساس الذي كون البناء
كله، هنا صار بإمكان رجلنا أن يحاور، بل صار من واجبه أن يحاور،
لذا لا سكوت هنا، بل جواب صريح وواضح يسمي الأشياء بمسمياتها، ويقول له، دون
مواربة: أكفرت؟..
}قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ
رَجُلاً} [الكهف:37/18 [ ويذكره، خلال ذلك،
بأدوار استحالته هو، من العدم (من التراب) إلى الكينونة (الرجل).. كما لو أنه يشير
هنا إلى أن كل كينونة
إنسانية، لا بد أن تمر بمراحل التطور هذه، وأن مقارنته السابقة كانت ظالمة، مثل
مقارنة نطفة، برجل..
فلننتبه هنا أن “رجلنا” لم تبهره ثروة صاحب
الجنتين، كما أنه لم يكن مصاباً بعقدة نقص أمام نجاح صاحبه، ليس لأنه
زاهد في الدنيا وما فيها، أو لأنه يريد الآخرة بمعنى عزل ذلك عن الدنيا، بل لأنه صاحب “ثوابت”، وبناؤه الذي يسعى لإنجازه يجب أن يكون
مبنياً على أسس واضحة ومتينة، وأي بناء آخر، مبني على أسس أخرىـ مناقضة أو مضادة،
يجب ألا يهزه أو يغويه، مهما تطاول وبدا براقاً..
كان
صاحب الثوابت، في طور استحالته هذه، مفكراً يؤمن بتكريس وتحديد الثوابت، لا من أجل الدفاع عن الهوية ضد آخر يؤمن بعكس
ما يؤمن، بل من أجل مشروعه الخاص، من أجل أن ينفذ من طور استحالة
إلى آخر، فدون هذه
الثوابت، ما كان يمكن لطور الاستحالة أن ينجز لأن الأساس في هذا الطور هو تحديد
هذه الثوابت وبلورة وتوضيح حدودها، لأن هذا الأمر مهم لأية فكرة
تمر بأطوارها الجنينية، أن تحدد ما هو أساسي، وما يجب المحافظة عليه، ما هو جوهر،
وما هو حجر أساس يرتكز عليه السياق كله..
تحديد
الثوابت مهم لهذه المرحلة، ومهم لتطور المراحل اللاحقة، لأن عدم الوضوح، وعدم وجود
حدود واضحة، قد يعرض
الفكرة لموت مبكر، عبر نفاذ أفكار أخرى، تمر بأطوار استحالة أكثر تطوراً،
وتملك لذلك بريقاً أكبر قد يسهل دخولها، وحتى هيمنتها، ما لم تكن هناك حدود واضحة،
حدود الثوابت التي هي المقياس والمعيار الذي يجب مقارنة النتائج، وتطور المراحل،
على أساسه..
ولو
أننا كنا في ذلك الطور، لسمعنا، وربما لقلنا شخصياً، للرجل صاحب الثوابت، أن يكف
عن ذلك، وأن ينظر إلى ما أنجزه صاحب الجنتين، أن ينظر إلى ثمره، أو مستوى دخله،
إلى الرفاهية التي حققها لشعبه، إلى تطاول بنيانه، إلى التقانة التي حققها.. سنسمع
من يقول له: إنه يكابر، وإنه “ينتقد” فقط لأنه فاشل، وإنه مهما كانت هناك سلبيات
لمشروع صاحب الجنتين، فإن ذلك أفضل من اللاشيء، أفضل من الأفكار المطلقة والتنظير
المجرد الذي يروج له الرجل المؤمن، سنسمع من ينصحه بأن يحاول الالتحاق بصاحب
الجنتين، أن يكون جزءاً من مشروعه، أن يجد له وظيفة عنده، أن يتعلم عنده “الصنعة”،
وأن يفهم كيف وصل لما وصل إليه.. كيف وصل “لثمره”.. وسيكون ذلك كله منطلقاً من
مقارنة غير عادلة بين مراحل غير مترابطة، مقارنة بين ثمر في وقت حصاده، وبين بذرة
قد زرعت للتو.. سيكون المنطلق صحيحاً لو أن صاحب البذرة لا يضمر لها غير أن تكون بذرة فقط، لو أنه ينوي
الاكتفاء بالتنظير المجرد، لكن التنظير للنهوض وتحديد الثوابت جزء من مشروعه، مرحلة لا بد أن يمر بها،
طور استحالة يمر عبره، ويتبلور عبره، وتتحدد شخصيته أكثر، ليكون
مهيئاً، لطور آخر، وآخر،
وصولاً إلى ما كان يبدو أنه المستحيل بعينه :النهضة..
3)
نزول للواقع من أجل فهمه بناءا على ما سبق
(موسى والخضر)
السرد
القرآني لقصة موسى والخضر يمتلك عدة مستويات للقراءة، كل مستوى منها لا يلغي
الآخر، بل
يتكامل معه، ويتدرج معه إلى المستوى العام الشامل، وكل هذه
المستويات بريئة تماماً مما رسب في الخيال الشعبي من القصة، التي حولت الخضر إلى
شخصية أسطورية لم تذق طعم الموت، ونسجت في ذلك القصص والحكايات، وجعلت له مقاماً
يستحق النذور في كل بلد، وهذا كله هو النقيض تماماً ليس من السرد القرآني لهذه
القصة فحسب، بل من كل ما أراده لنا القرآن ومن كل مقاصده وأهدافه..
محور
قصة موسى والخضر، في جوهرها، هو
النزول بالفكر والعقيدة إلى الواقع، إلى التفاعل الاجتماعي
الحقيقي الذي يدخل هذا الفكر كطرف في معادلة البناء الاجتماعي، إنه النزول
بالنظرية من إطار التنظير إلى إطار التطبيق، حيث المحك الحقيقي لمصداقيتها، فقوة
أية نظرية، في النهاية، ليست
في تماسكها ضمن إطارها الفكري وجدالها مع النظريات الأخرى، ولكن قوتها هي في صمودها
عندما تتفاعل مع الواقع وتمكنها من الإثمار فيه والوصول إلى أهدافها عبره.
امتحان
أية نظرية هو في تمكنها من إثبات أن ما تنادي به ليس مجرد شعارات برّاقة، بل هو
حقيقة يمكن الوصول إليها.. والانتقال من الإطار النظري إلى الإطار التطبيقي،
والنجاح هناك أصعب بكثير من البقاء في أسر النظرية.. قصة موسى والخضر تفتح أعيننا
على ذلك، فإذا بها تقدم لنا رؤية جديدة للعلاقة بين الشريعة والحياة، وتقدم لنا
زاوية أكثر انفراجاً ننظر فيها ومن خلالها لكل
من أحكام الشريعة وأحكام الحياة، فإذا بالاثنين يلتحمان معاً، بدلاً من انفصالهما
المزعوم، وبدلاً من الهوة التي يشتكي منها الجميع، نجد ذلك
التماهي بين الاثنين الذي يرفع مستوى الحياة، ويخرج الشريعة من رفوف الكتب وأطر
التنظير..
على
درب الالتحام بين الشريعة والحياة، تأخذنا قصة موسى والخضر، من الرؤية الجزئية للنصوص، إلى الرؤية
الشمولية لها، ومن الفهم “التبعيضي” إلى الفهم “الشمولي”، ومن الألواح
الحجرية الجامدة التي نحتت عليها هذه النصوص، إلى واقع تشكله النصوص..
أول
ما يلفت النظر في السياق القرآني هو أن موسى، كليم الله، صاحب المنزلة الرسولية
المهمة، والأعلى قطعاً في زمانه، لم يتردد –على الرغم من مكانته– في السفر لغرض التعلم وطلب العلم، ولكن فلننتبه هنا إلى أنه
هذا ليس مجرد تواضع طالب العلم، بل معرفته
المسبقة أن النزول من المكتبة أو البرج العالي يتطلب علماً إضافياً، علم ما بين
السطور، علم روحية النص ومقصده، وذلك لا يحدث إلا بالجمع بين النص والواقع،
عبر رؤية شمولية لكل من النص والواقع، وهنا تأتي تلك الإشارة المذهلة إلى عزم موسى
على الوصول إلى مجمع البحرين} :وَإِذْ قالَ مُوسَى لِفَتاهُ لا
أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً} [الكهف:18/60 [ فمجمع البحرين هنا
كناية عن ذلك التلاحم والالتقاء الفعال بين أمرين مهمين، بين النص الذي سيظل مهماً
حتى في حرفيته، وبين فقهه وفهمه بشكل يجعل حروفه تثمر وتنتج واقعاً جديداً..
شيء
آخر يلفت النظر هنا، وهو أن موسى يحدد الرشد،
كمطلب أساسي، وليس العلم فحسب:
{قالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكُ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ
مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً} [الكهف:18/66 [ فليس العلم
هو ما ينقص موسى، ولكنه يريد الرشد، أي كيف يكون هذا العلم الذي عنده ضمن منظومة
موصلة إلى الحق.. أي إنه ليس العلم المجرد.. ليس العلم فحسب، بل العلم الموصل إلى بناء المجتمع من جديد.
يلفت
النظر أيضاً هنا في ردّ الخضر أمرين اثنين:
الأول – أن الخضر طالبه بالصبر ابتداءً }قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} [الكهف:18/67 [ وهذا يشير إلى صعوبة المهمة ووعورة الطريق الفاصل بين النقطتين.
الأول – أن الخضر طالبه بالصبر ابتداءً }قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} [الكهف:18/67 [ وهذا يشير إلى صعوبة المهمة ووعورة الطريق الفاصل بين النقطتين.
الثاني
– هو أن الصعوبة يحددها الخضر في “عدم الإحاطة}” وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى ما لَمْ
تُحِطْ بِهِ خُبْراً} [الكهف:18/68 [ أي إن
المشكلة هي في فهم
تجزيئي، فهم تبعيضي، لا يرى من الأمور غير بعض الجزئيات التي تجعل
من الإثمار ومن إنتاج الواقع الجديد أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، أما
“الإحاطة” التي أشار إليها الخضر، فهي ذلك الفهم الشمولي الذي فيه الكل غير منفصل
عن الجزء، والتفاصيل منتظمة داخل منظومتها أوسع، بشكل يجعلها فاعلة ومتفاعلة.. كل
ما علمه الخضر لموسى كان يرتكز على إزالة
الفهم الجزئي –للنص أو للواقع– وعلى إحلال رؤية شمولية تجمع النص بالواقع..
الرحلة
فيها ثلاثة مواقف، يجعلنا السياق القرآني نمر فيها أولاً ونحن نرى بعدسة سيدنا
موسى، فنكاد نهب معه معترضين على ما نرى، ثم يجعلنا السياق القرآني نمر على
المواقف نفسها ولكن هذه المرة ونحن نرى بعين الخضر، فنرى كل شيء مختلفاً، ونوافق
على ما فعل الخضر كما لو أننا لم نعترض قبل قليل.
والفرق بين موقفنا في الحالتين هو الفرق بين الحكم المبني على الرؤية التجزيئية، والآخر المبني على الرؤية الشمولية.. في الموقف الأول، وعبر الرؤية التجزيئية نرى )السفينة(، ونرى الخرق الذي أحدثه الخضر، فلا نرى غير النتيجة المباشرة لهذا، ولذلك نقف مع اعتراض سيدنا موسى، لكن عبر الرؤية الشمولية، تتسع زاوية الرؤية فنرى السفينة ضمن محيطها الاجتماعي الأوسع، فلا تبقى السفينة مجرد ألواح وخشب، مجرد وجود فيزيائي، بل تصير مرتبطة بالنسيج الاجتماعي الذي يرتبط بهذه السفينة، فإذا عليها مساكين يعملون في البحر، ووراءهم ملك يغتصب ما يحلو في عينه من الممتلكات ومنها السفن، وهكذا سيبدو أمر المحافظة على السفينة، ولو بعيب، ولو بتعرضها لخطر يستطيع عمالها إصلاحها لاحقاً، أهم من المحافظة على سلامة ألواحها وخشبها، مقابل اغتصاب الملك لها..
والفرق بين موقفنا في الحالتين هو الفرق بين الحكم المبني على الرؤية التجزيئية، والآخر المبني على الرؤية الشمولية.. في الموقف الأول، وعبر الرؤية التجزيئية نرى )السفينة(، ونرى الخرق الذي أحدثه الخضر، فلا نرى غير النتيجة المباشرة لهذا، ولذلك نقف مع اعتراض سيدنا موسى، لكن عبر الرؤية الشمولية، تتسع زاوية الرؤية فنرى السفينة ضمن محيطها الاجتماعي الأوسع، فلا تبقى السفينة مجرد ألواح وخشب، مجرد وجود فيزيائي، بل تصير مرتبطة بالنسيج الاجتماعي الذي يرتبط بهذه السفينة، فإذا عليها مساكين يعملون في البحر، ووراءهم ملك يغتصب ما يحلو في عينه من الممتلكات ومنها السفن، وهكذا سيبدو أمر المحافظة على السفينة، ولو بعيب، ولو بتعرضها لخطر يستطيع عمالها إصلاحها لاحقاً، أهم من المحافظة على سلامة ألواحها وخشبها، مقابل اغتصاب الملك لها..
في
الموقف الثاني نرى أولاً “الغلام”،
مجرد غلام لم يرتكب ما يستحق أن يقتل من أجله، لذلك سنرى موسى محقاً في اعتراضه،
لكننا لاحقاً نرى أن الغلام
ليس معزولاً عن وسطه الاجتماعي، وأن له تأثيراً سلبياً على أقرب المقربين له:
أبويه. إنه ذلك
“الابن” الذي تتبين ملامح عقوقه وجحوده مبكراً، وتكون إزالته المبكرة، على ما في
ذلك من ألم، أقل إيلاماً من الإبقاء عليه وعلى مشاكله وعلى ما سينتج عنه من سلبيات
يكبر حجمها مع الوقت؛ لذلك فإن (قتله) هنا وفي هذه المرحلة، وبينما أبواه لا
يزالان قادرين على الإنجاب، سيسبب لهما الألم حتماً، لكنه سيدفعهما إلى تكرار
الإنجاب..
في
الموقف الثالث نرى موسى والخضر وهما بحاجة إلى طعام وضيافة، وهنا سيكون من حق موسى
المطالبة بأجر يقيم أودهما لقاء ما أقامه الخضر من جدار كان آيلاً للسقوط، لكن
الرؤية الأوسع، ستجعلنا نرى مجتمعاً
آيلاً للسقوط، وليس فقط جداراً متهاوياً، مجتمع بلغَ أفراده حداً
من الفردية والانغلاق لدرجة أن المجتمع مقبل على التشظي، الرؤية الأولى تجعلنا نرى
جداراً يشرف على السقوط، ومعدتين خاويتين، أما
الرؤية الثانية فهي تجعلنا نرى بناءً اجتماعياً يشرف على السقوط وفقدان آتٍ لكل
قيم العدالة والتكافل الاجتماعيين، “إقامة الجدار” هنا كانت عملاً ترميمياً يمد في عمر البناء،
دون أن يعني ذلك أن هذا هو الحل، فهذا المجتمع كان يحتاج إلى جيل جديد قادم (ممثلاً في الغلامين اليتيمين، النبتة الصالحة التي ذاقت
معنى الظلم الاجتماعي)، وهو جيل سيستطيع أن يستثمر الكنز الدفين عبر هدم واعٍ لأسس
هذا البناء الاجتماعي، هدم
بتخطيط مسبق، وليس مجرد انهيار عشوائي.. أي إن إقامة الجدار هنا كانت إطالة
لعمره إلى الوقت الذي يجب أن يهدم فيه تماماً.
لكن
لماذا لم يأخذ الخضر الأجر؟ ليس فقط لأن الاستثمار
الأهم بعيد المدى كان في الكنز، ولكن لأن المطالبة بالأجر، بعد
إقامة الجدار، قد تجعل صنفاً كهذا من الناس، يندفع إلى هدم الجدار من أجل التهرب
من دفع الأجر، وكان هذا سيكشف الكنز، لذا كان يجب تناسي الأمر، من أجل ذلك
الاستثمار ربحاً، الذي سيأتي على يد جيل آخر، قادم لا محالة..
الخرق الذي أحدثه الخضر لم يكن في السفينة فقط،
بل كان خرقاً في ذلك الفكر التجزيئي الذي يجعلنا نعجز عن
رؤية ما هو أبعد من أطراف أنوفنا، إنه خرق يجعلنا نرى العالم من زاوية أوسع، زاوية
أكثر شمولية وانفراجاً، فإذا بالنصوص تتمكن من المساهمة في إعادة بناء العالم،
بدلاً من أن نجدها متخبطة وقد سلبت منها فاعليتها..
ما
يلفت النظر هنا، أن كل موقف من هذه المواقف الثلاثة، ابتدأ بـ)وانطلقا(، كما لو أن
نقطة الانطلاق الحقيقي
إلى الواقع، يجب أن تمتلك عدة الفهم الشمولي، لكي تتمكن من إعادة تشكيل الواقع.. لا الذوبان فيه مع
الرؤية التجزيئية.. كما لو أن الانطلاق إلى النهضة الحقيقية لا يمكن إلا من هذه
المنصة: منصة الفهم الشمولي..
وسيكون
من المؤسف جداً هنا، أن نرى كيف تحول هذا السرد الباعث للحياة إلى مادة أسطورية
مليئة بالخرافات عن رجل لم يعرف الموت.. وله في كل بلد مقام تقدم له نذور هي
بالتأكيد المثال العملي لكل ما هو ليس من الإسلام..
مقام الخضر الحقيقي ليسَ هناك، بل مقامه هنا،
في هذا السرد القرآني لعملية النزول إلى الواقع.. وعندما نبث الحياة في الفهم الشمولي
المنبعث من هذا السرد، فإن الواقع سيخضر ويثمر.. وستنهار تلك الهياكل الخرافية،
التي كانت آيلة للسقوط طول هذه الفترة ..
4)
التنفيذ (ذو القرنين)
لم
تكن عملية نزول الفقه إلى الواقع التي شكلتها رحلة سيدنا موسى مع الخضر، عملية
مفرغة من المقاصد التالية، ولم تكن المعرفة الشمولية (التي نتجت من التأويل الذي
“خرق” مركب الرؤية التجزيئية) هي المحطة الأخيرة في تلك الرحلة، بل كانت “موقفاً”
أساسياً، احتاجته رحلة الفكر، ليزودها بالطاقة اللازمة للانطلاق إلى المحطة –
الهدف، إلى ذروة الرحلة التي بدأت من كهف صغير، مع مجموعة من الفتية.. إلى أن
وصلت، ومع أواخر سورة الكهف، إلى القمة المرجوة، إلى ذي القرنين..
ليس
مهماً هنا أبداً، نسبه واسمه وزمانه ومكانه، ليسَ مهماً إن كان اسمه الإسكندر
المقدوني أو هرمس أو مرزبان أو هرديتس أو الصعب بن ذي يزن، ليس مهماً أن كان في
عهد إبراهيم، أو عهد المسيح، وليس بعيداً أن يكون أكثر من شخص، كما قالت بعض
التفاسير.. لكن فلنتذكر هنا أن كل تفصيلات الزمان والمكان وما يتعلق بهما هي مجرد
تفاصيل تعالى عنها النص القرآني، وجعلنا بهذا التعالي ندخل في جوهر الأمر، الذي هو
علامته الفارقة في الوقت نفسه..
سيستوقفنا
الاسم، ولن نقتنع كثيراً بأن ذلك كان يعود لضفيرتين في رأسه، أو لخوذة بقرنين، لكن
سيلفت نظرنا قول البعض: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن، ولأنه دخل الظلمة والنور،
ولأنه ملك فارس والروم. تلك الثنائيات، المنبثقة من “القرنين” ستشدنا للمزيد: هل
لأنه كان رمزاً لحضارة جمعت العدل والقوة؟.. والدنيا والآخرة؟.. هل لأنه كان رمزاً
لتوازنات حضارة تمكنت من المادة دون أن تنأى عن الروح؟ هل مجموعة التوازنات هذه هي
التي شكلت حضارة الذروة هذه؟ أو أن هذه التوازنات تسهم في المحافظة على الذروة لفترة
أطول وتؤخر دورة الانهيار التي لا بد أن تمر على كل الحضارات؟..
سنقرأ
ما كتبه بعض المفسرين من أن الخضر كان حامل لواء ذي القرنين بعين جديدة.. لا إسناد
قوياً على هذا القول طبعاً، لكن هل كانت هذه هي طريقة الأولين في التعبير عما نراه
اليوم من ارتباط رحلة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وما تعلمه منه، مع الوصول إلى
حضارة ذي القرنين..
وسيقول
لنا القرآن الكريم مباشرة عن سر التمكين الإلهي لذي القرنين، ليس من أسرار هناك في
الأمر أصلاً، فهذه الحضارة تشترك فيما تشترك فيه كل حضارة تصل إلى القمة، لكنها
تزيد على ذلك، فلا بد لكل حضارة أن تتمكن من الأسباب، من العلوم، لكي تصل إلى
مرتبتها القصوى، لكن حضارة ذي القرنين ليست أية حضارة، إنها الحضارة الذروة في
السياق القرآني، وذلك لأن الأسباب التي أوتيت له، كانت “من كل شيء”.. أي إنها تعبر
عن علم شمولي برؤية شمولية، رؤية لا تجزئ الإنسان ولا تجزئ الواقع، وسيضعنا ذلك
مرة أخرى وسط التوازنات التي شكلها وكوّنها ذو القرنين، وسيضعنا أيضاً على صلة
مباشرة بالرؤية الشمولية التي حرص الخضر والقرآن على زرعها كعدسة نصفها في أعيننا
عندما نقرأ الواقع، وعندما نتعامل مع النص..
إنها
أسباب كل شيء، العلم الشمولي المتكامل الذي لا يهمل فيه جانب لحساب جانب آخر، ولكن
هذا ليس كل شيء مرة أخرى، إذ إن هذا العلم الشمولي، علم الأسباب المتكاملة، يستثمر
من أجل إصلاح العالم، ذلك أنه ليس علماً يخص قوماً بعينهم أو أمة بعينها، لكنه علم
الإنسانية جمعاء، لذلك سنرى ذي القرنين وهو (يتبع سبباً)، وفي كل مرة تتكرر تلك
الآية سنراه وهو يجوب العالم لإصلاحه ونشر الحق والعدل فيه، والأمر هنا ليس خاضعاً
للنسبية الأخلاقية المزعومة، بل هو مرتبط بمنظومة قيم سماوية، لكن الفهم الشمولي
لها هو الذي سيكون ضمانتها من السقوط في الجمود وحرفية التطبيق بمعزل عن مقاصدها
وغاياتها؟..
سنرى
حضارة ذي القرنين تفتح العالم شرقاً وغرباً، تعيد ترتيبه وتكوينه، ليكون عالماً
أفضل، سنراه يذهب أولاً إلى حيث تغرب الشمس، إلى حيث الأفول، وسنرى “العين الحمئة”
هنا، التي تغرب الشمس فيها، مثالاً رمزياً على كل حضارات الأفول، تلك التي تستنفد
قيمها ربما دون أن تفقد مظاهر قوتها، لذلك فهي تظل “نبعاً” وتظل تبث قيماً ترتبط
بما هو سفلي في الإنسان، وكونها “نبع” و”طيني” هو ما تمثله كلمة (عين حمئة)
التي تعبر عن مظهر أفول وغروب كل حضارة.. سنلاحظ هنا أن التواصل قد يكون
ممكناً مع حضارة الأفول، وأن بوصلة القيم المرتبطة بالآخرة، وبالإيمان والعمل
الصالح، وبالعدل، قد تثمر، عند تفاعلها، ولو كان فصل هذه الحضارة، هو شتاء
الأفول..
على
الجهة الأخرى من التفاعل، سنرى ذا القرنين وهو يذهب إلى حيث تطلع الشمس، من حيث
يفترض أن تبدأ الحضارة بالبزوغ، وسنرى النقطة الحضارية صفراً، قبل أن تنشأ نواة
الحضارة، حيث يشير النص القرآني إلى أنه لم يكن هناك ستر بين القوم عند النقطة
صفر، وبين الشمس.. أي إنهم في مرحلة “ما قبل البناء”.. وذلك سيعني فوراً أنهم قبل
الاستقرار، في مرحلة قد تشبه الرعي أو البداوة.. أو أي شيء ما بينهما.. وهذا يعني
أنهم لم يدخلوا معادلة الحضارة التي تتضمن إعمار الأرض وتحتم الاستقرار كمرحلة
أولية..
وبين
المطلع والمغرب، سنجد هناك قوماً عزلوا أنفسهم خارج المعادلة الحضارية وشروط
حركتها، حبسوا أنفسهم بين سدين، وصاروا وراءه، ربما كانوا يتصورون بذلك أنهم
يحافظون على ما لديهم، لكن نتيجة هذا كانت الانغلاق لدرجة أنهم صاروا لا يفقهون
قولاً، و”عدم الفقه” هذا ليس ناتجاً فقط عن اختلاف لسان، بل عن عدم وجود قاعدة
مشتركة للحوار، انعزالهم جعلهم غير قادرين على التواصل مع أيٍّ كان، جعل رؤيتهم
تجزيئية وبالتالي جامدة، وهذا كله جعل من فاعليتهم محصورة في الإفساد في الأرض،
فكانوا يأجوج ومأجوج..
وسنرى
أن القوم الذين يخاطبون ذا القرنين يطالبون بحمايتهم من يأجوج ومأجوج ليسوا
بالضرورة قومه، لكنه رمز لحضارة إنسانية تتعالى عن العرق والقوم واللون
والجغرافية، وسنرى القوم يعرضون عليه “خرجاً= ثمنا” مقابل ذلك، لكنه يرفض، لأن
التمكين مسؤولية وتكليف وليس تشريفاً، ولذلك فالتصدي للخطر هو من صلب مسؤوليته،
لكنه ليس من مسؤوليته وحده، بل مسؤوليتهم جميعاً، لذا فهو يطلب منهم المشاركة،
بدلاً من أن يطالبوا فقط، إنه التوازن بين أداء الواجب والحصول على الحق، وسنرى
كيف يذوب الفرد في الأمة والأمة في الفرد، الأنا في النحن والنحن في الأنا، سنرى
كيف يشاركون بأنفاسهم في الأمر (وانفخوا)، وسيكون التماسك الاجتماعي الذي مثله كل
هذا مرتبطاً بالتماسك المادي الذي مثلته التقنية هنا: الحديد مع القطر، وسيكون ذلك
كله محققاً لنتائج أفضل حتى من المطلوب، فقد كان المراد أولاً: مجرد سد يحجز يأجوج
ومأجوج، لكن الذي تحقق كان “الردم”، وهو أكبر وأبلغ من السد، ويذكر بذلك الذي يجمع
بين الثنائيات كلها: الدنيا والآخرة، الروح والجسد، المادة والغيب، الفكر والسلوك.
سيبدو
الردم هنا تلك القمة التي وصلها ذو القرنين والتي يمكن أن يصلها كل من يحاول اتباع
الأسباب الشاملة، لصنع عالم أفضل..
ستكون
تلك المحطات الثلاث، وتلك القمة العالية التي وصلها ذو القرنين بمثابة استفزاز لنا
لكي نعرف ما موقعنا من الإعراب في جملة الحضارة، هل نحن “بين السدين” وقد أغلقنا
على أنفسنا رؤيتنا التجزيئية للعالم ولأنفسنا وللنص، فتحولنا إلى الإفساد في الأرض
سواء وعينا أم لم نعِ.. أم هل نحن لم نصل لذلك أصلاً؟.. ولا نزال عند “العين
الحمئة”- الغربية؟ باعتبار أن طينها هو أفضل ما يمكن الوصول إليه..
يتوهج
النص القرآني بين أيدينا ونحن نعيد فهمه بضوء شروط الحضارة، يتوهج هو، ويبعث
الضوء..
بقي أن نتوهج نحن!..
بقي أن نتوهج نحن!..
*****
________________________________________________
الحب لا .. الرحمة نعم
 |
| by Mahmoud Fathy |
لـ د.مصطفى محمود
بالرغم من قيمة مشاعر الحب عندي
وعندكم معاشر القراء و القارئات، وبالرغم من أن الحب يكاد يكون صنم هذا العصر الذي
يُحرق له البخور، و يُقدم له الشباب القرابين من دمائهم، و يُقدم له الشيوخ
القرابين من سمعتهم، وتُرتل له الأناشيد، ويُزمر له الزامر، و يُطبل الطبّال،
وترقص الراقصة، وتعمل بلاتوهات السينما، وستوديوهات التليفزيون ، و كباريهات شارع
الهرم ليل نهار لتمجيده ورفعه على العرش، ليكون المعبود الأول والمقصود الأول،
والشاغل الأوحد و الهدف الأوحد، والغاية المُثلى للحياة التي بدونها لا تكون
الحياة حياة .
و بالرغم من أننا جميعا جُناة أو
ضحايا لهذا الحب، وليس فينا إلا من أصابه جرح أو سهم أو حرق ، أو أصاب غيره بجرح
أو سهم أو حرق . بالرغم من هذه الأهمية القصوى ، والصدارة المطلقة لموضوع الحب في
هذا الزمان ، فإني أستأذنكم في إعادة نظر و في وقفة تأمل، و في محاولة فهم لهذا
التيه الذي نتيه فيه جميعا شيوخا و شبابا و صبايا .
و أسأل نفسي أولا و أسألكم : هل تعلمون
لماذا يرتبط الحب دائما بالألم، و لماذا ينتهي بالدموع و خيبة الآمال ؟! دعوني
أحاول الإجابة فأقول : إن الحب والرغبة قرينان .. و إنه لا يمكن أن تُحب امرأة دون
أن ترغبها، و لهذا ما تلبث نسمات الحب الرفافة الحنون أن تمازج الدم و اللحم، و
الجبلة البشرية، فتتحول إلى ريح و إعصار و زوبعة، حيث ينصهر اللحم والعظم في أتون
من الشهوة العارمة، و اللذة الوقتية التي ما تكاد تشتعل حتى تنطفئ .
هل أقول إن الحب يتضمن قسوة خفية، و عدوانا
مستترا ؟ نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة، و هو لابد أن يتلون بالشهوة بحكم
البشرية، و المرأة التي تشعر أن الرجل استولى على روحها، تحاول هي الأخرى أن تنزع
روحه و تستولي عليها .. و في ذلك عدوان خفي متبادل، و إن كان يأخذ شكل الحب. و المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الحب في القرآن هي قصة امرأة العزيز التي شغفها
فتاها ( يوسف ) حبّا.
فماذا فعلت امرأة العزيز حينما تعفف
يوسف الصدّيق؟ وماذا فعلت حينما دخل عليهما الزوج ؟ لقد طالبت بإيداع يوسف السجن و
تعذيبه، ( قَالَتْ مَا جَزَاء
مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 25) ( ) يوسف . و ماذا قالت لصاحباتها وهي تروي قصة
حبها؟ ( وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ
فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا
مِّنَ الصَّاغِرِينَ (32) ( يوسف . إن عنف حبها اقترن عندها بالقسوة
والسجن والتعذيب.. و ماذا قال يوسف الصدّيق؟ ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (33) ( يوسف . لأنه أدرك ببصيرته أن الحب سجن، و أن الشهوة قيد، إذا
استسلم له الرجل أطبق على عنقه حتى الموت.. و رأى أن مكثه في السجن عدة سنوات،
أرحم من الخضوع للشهوة التي هي سجن مؤبد إلى آخر الحياة .
إن الحب لا يظل حبا ًصافياً رفافا
ًشفافاً، و إنما ما يلبث بحكم الجبلة البشرية أن يصبح جزءاً من ثالوث هو: الحب و
الجنس و القسوة، وهو ثالوث متلاحم يقترن بعضه ببعض على الدوام. ولأن قصة الحب التي
خالطتها الشهوة ما تلبث أن تنتهي إلى الإشباع في دقائق، ثم بعد ذلك يأتي التعب
والملل والرغبة عند الإثنين في تغيير الطبق، و تجديد الصنف لإشعال الشهوة و الفضول
من جديد.. لهذا ما يلبث أن يتداعى الحب إلى شك في كل طرف من غدر الطرف الآخر.. و هذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الارتياب والتربص والقسوة والغيرة، وهكذا يتحول
الحب إلى تعاسة وآلام ودموع و تجريح. والحب لا يكاد ينفك أبداً عن هذا الثالوث..
(( الحب و الجنس و القسوة )).. وهو لهذا مقضى عليه بالإحباط وخيبة الأمل، و محكوم
عليه بالتقلب من الضد إلى الضد، و من النقيض إلى النقيض.. فيرتد الحب عداوة و
ينقلب كراهية وتنتحر العواطف كل يوم مائة مرة.. و ذلك هو عين العذاب. و لهذا لا
يصلح هذا الثالوث أن يكون أساسا لزواج.. و لا يصلح لبناء البيوت، و لا يصلح لإقامة
الوشائج الثابتة بين الجنسين .
و من دلائل عظمة القرآن و إعجازه أنه
حينما ذكر الزواج، لم يذكر الحب وإنما ذكر المودة والرحمة والسكن.. سكن النفوس
بعضها إلى بعض.. وراحة النفوس بعضها إلى بعض.. وقيام الرحمة وليس الحب.. والمودة و
ليس الشهوة.
(وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ( الروم (21) . إنها الرحمة و المودة.. مفتاح البيوت، والرحمة تحتوي على الحب بالضرورة.. و
الحب لا يشتمل على الرحمة، بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدواناً. والرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر.
والرحمة عاطفة إنسانية راقية مركبة، ففيها الحب، وفيها التضحية، وفيها إنكار
الذات، وفيها التسامح، وفيها العطف، وفيها العفو، وفيها الكرم. وكلنا قادرون على
الحب بحكم الجبلة البشرية.
و قليل
منا هم القادرون على الرحمة.. وبين ألف حبيبة هناك واحدة يمكن أن تُرحم، و
الباقي طالبات هوى و نشوة و لذة. ولذلك جاء كتاب الحكمة الأزلية الذي تنزل علينا
من الحق.. يذكرنا عند الزواج بالرحمة والمودة والسكن.. ولم يذكر كلمة واحدة عن
الحب، محطماً بذلك صنم العصر ومعبوده الأول، كما حطم أصنام الكعبة من قديم. و
الذين خبِروا الحياة وباشروا حلوها ومرّها، و تمرسوا بالنساء يعرفون مدى عمق و
أصالة و صدق هذه الكلمات المنزلة. وليس في هذه الكلمات مصادرة للحب، أو إلغاء
للشهوة، وإنما هي توكيد، وبيان بأن ممارسة الحب والشهوة بدون إطار من الرحمة
والمودة والشرعية هو عبث لابد أن ينتهي إلى الإحباط. و الحيوانات تٌمارس الحب والشهوة
و تتبادل الغزل. وإنما الإنسان وحده هو الذي امتاز بهذا الإطار من المودة والرحمة
والرأفة، لأنه هو وحده الذي استطاع أن يستعلي على شهواته؛ فيصوم وهو جائع ويتعفف
وهو مشتاق .
والرحمة ليست ضعفا وإنما هي غاية
القوة، لأنها استعلاء على الحيوانية والبهيمية والظلمة الشهوانية. الرحمة هي النور
والشهوة هي النار. وأهل الرحمة هم أهل النور والصفاء والبهاء، و هم الوجهاء حقاً.
و القسوة جبن والرحمة شجاعة. ولا يُؤتى الرحمة إلا كل شجاع كريم
نبيل. ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهل الصغار والخسة والوضاعة. و الرحمة هي
خاتم الجنة على جباه السعداء الموعودين من أهل الأرض.. تعرفهم بسيماهم و سمتهم و
وضاءتهم. و علامة الرحيم هي الهدوء والسكينة والسماحة، ورحابة الصدر، والحلم
والوداعة والصبر والتريث، ومراجعة النفس قبل الاندفاع في ردود الأفعال، وعدم
التهالك على الحظوظ العاجلة والمنافع الشخصية، والتنزه عن الغل وضبط الشهوة، و طول
التفكير وحب الصمت والائتناس بالخلوة وعدم الوحشة من التوحد، لأن الرحيم له من
داخله نور يؤنسه، و لأنه في حوار دائم مع الحق، وفي بسطة دائمة مع الخلق. والرحماء
قليلون، وهم أركان الدنيا وأوتادها التي يحفظ بها الله الأرض و من عليها. ولا تقوم
القيامة إلا حينما تنفذ الرحمة من القلوب، ويتفشى الغلّ، وتسود المادية الغليظة،
وتنفرد الشهوات بمصير الناس، فينهار بنيان الأرض وتتهدم هياكلها من القواعد .
اللهم إني أسألك رحمة
اللهم إني أسألك مودة تدوم
اللهم إني أسألك سكناً عطوفاً و قلباً
طيباً
اللهم لا رحمة إلا بك و منك و إليك
اللهم لا رحمة إلا بك و منك و إليك
*****
________________________________________________
هتك السر
مصطفى محمود، عصر القرود
غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى المكاشفة التامة مع
حبيبه، وأن تزول بينهما المسافة .. وأن
يصبح هو هى.. وهى هو .. وأن ينتهي السر .. ويهتك الحجاب..
وهو وهـــم شائع، وخطأ
بات من كثرة التداول حقيقة الكل مسلم بها ، فلو
انهتك الحجاب بين اثنين ،لانتهى الحب بينهما فوراً..
فالحب :
قرب وليس فناء.. هو
تلامس أسرار وليس تعرية وانكشافاً..
.........
هل تحب ان يدخل عليك احد ((التواليت)) ؟ !ً
وماذا يكون شعورك وأنت ترى أحداً يطلع عليك وأنت
تباشر هذه الضرورة ؟!
مع ذلك
فهي حقيقة .. نحن نأكل ونشرب .. ونخرج فضلات
ولنا لحظة شهوة نكون فيها أكثر عبودية..وبالتالي أكثر
خجلاً من انفسنا..
ومن هنا جاءت كلمة :العورة .. وكلمة الستر..
فذلك ضعف لا نحب أن نطلع أحدا عليه .. برغم
انه أمر معروف ومشترك فينا جميعاً ..
ثــم
ان الحب عاطفة تهفو .. وتشب .. وتتطلع .. طالما كان
هناك فضول .. وتشتعل طالما كان هناك سر..
فالـــسر: يشعل الخيال
والخيال : مادة
الحب وخامته
وبدون خيال لا يبقى إلا تبادل المصالح وإشباع الغرائز..
الخيال هو : الشعر
والوهم والأحلام
الخيال جناحان يطير بهما الحب ويعلو على الواقع،
وبدون هذين الجناحين ،يقع الحب .. ويتحطم .. ويجف ويذبل ويتكسر على أرض المـــصالح.
وإذا كنت تحرص على دوام حبك .. فلا تحاول أن تقتحم
هذه الأرض الحرام بينك وبين من تحب .. لا تحاول أن تهتك ستره .. لا تحاول أن تفتح
مخه أو تدخل قلبه..
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تجسسوا )
لأن الله أراد لكل واحد منا أن تكون له خصوصية لا
تُنتهك .. وسر بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا ربه..
ولكل منا وجه إلى الناس .. ووجه إلى الله .. وذلك
الوجه الثاني هو سره..
وانتهاك هذا الوجه عدوان .. وطمع من الحبيب فيما ليس
له ..
ولــهذا اشعر دائما بأن من يحاول أن يقتحم المسافة
بيني وبينه بإسم الحب .. إنما يفعل ذلك بحكم الكراهية وليس الحب .. فهو يريد ان
يلتقط لي صورة وانا في (التواليت) ويسجل علي الوسواس التي لا تليق بي .. ويحاول ان
يفضحني.
وذلك : هو الحب
الأناني الذي يريد في واقع الأمر أن يتخلص مني .. ويستهلكني .. ويستنفذني.. ويقضى علي ..
و تلك هى القسوة المقنعة التي نتبادلها باسم الحب .. والعدوان
الذي نباشره باسم العشق ..
ولهذا ضرب الله لنا مثلاً على الكمال باسمه (العزيز)
فهو سبحانه العزيز الذى لا ينال
وعلى من يريد أن يكون كاملاً أن يكون هو الآخر عزيزاً
لا ينال.. فالعزة والمنعة من صفات الكمال..
والشيوع والانكشاف من صفات الابتذال..
ومن هنا : وجب أن
تكون هناك مسافة بين الأحباء
وأن يكون الحب : قرباً
وليس اقتحاماً..
وتلك المسافة هي التي اسميها الاحترام .. حيث يحترم
كل واحد سر الآخر .. فلا يحاول ان يتجسس عليه .. ويحترم ماضيه .. ويحترم مايخفيه
في جوانحه .. ويحترم خصوصيته .. وخلوته وصمته .. ويحاول ان يكون ستراً وغطاء .. لا
هتكاً وتدخلاً وتلصصاً ونشلاً ..
الحب : عطاء
اختياري حُر .. وليس مصادرة قهرية وسلباً واغتصاباً.. وفي هذه الحرية جوهــــر الــحب..
يقول الله سبحانه عن عطاء الاسرار والعلم الذي يعطيه
لعبيده : ( ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما
شاء )
تلك هي الـــــعزة، فالله يعطي ما شاء من علمه لمن شاء.. لا يستطيع احد أن يغتصب منه ما لا يريد.
وبالمثل ( ولله المثل الأعلى) :
أهل الرحمة والمودة .. وأصحاب الأخلاق الربانية لا
يحبون ان يغتصبوا .. ولا أن تنتهك أسرارهم .. وإنما يحبون ان تظل لهم الحرية يعطون
من أسرارهم ما شاءوا لمن شاءوا .. وهم بالمثل لا يفكرون في انتهاك سر أحد أو
اغتصابه..
وتلك هي المــــسافة المقدسة، وذلك هو الحمى الخاص لنفوسنا .. لا يصح أن يطمح احد في
دخوله أو فضحه .. ومن يفعل هذا يقتل الحب ولا يحييه..
وحول هذه الحمى يجب أن نقيم نطاقات عديدة من الأسلاك
الشائكة..ونطلق العديد من كلاب الحراسة ونبني نقاطاً للإنذار المبكر ..
فذلك : قدس أقداس
الذات الذي لا يصح أن يطلع عليه أحد إلا رب الذات وخالقها، لأنه وحده الرحمن الرحيم الذي يرحم الضعيف. ولأنه وحده
الغفور الكريم الذي قال لنا أنه يغفر الذنوب جميعاً..
قال تعالى :( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )
ولهذه الرحمة الشاملة والمغفرة الكلية كشفت له الذات
وجهها دون خوف .. فى حين احتجبت عن العالمين ..
إن الله يحب عبده الصالح الراجع إليه أكثر من حب الأم
لإبنها .. وأكثر من حب الحبيب لحبيبته .. وأكثر من حب الراعى لشاته الضاله حين
يراها عائدة إليه.
وكيف لا يحبنا من نفخ فينا من روحه .. وأسجد لنا
ملائكته .. وسخر لنا أكوانه .. وفتح للمذنبين منا كنوز مغفرته.. بل نظلمه اذ ساوينا بين حبه وأى حب من هذه الهزليات التي
نقرؤها عن روميو وجوليت وقيس وليلى..
بل لا يساوى حرماننا من حبه حرماننا من اى حب ولا
حرماننا من أى غال، ولا يساوي غضبه علينا أي
غضب.. وعلى خطايانا يجب ان نبكي حقاً .. وليس
على أي هجر أو أي فراق أو أي مرض أو أي موت .. وذلك حال الذين قدروا الله حق قدره
.
وما يستطيعون .. لأنه
لا أحد يستطيع أن يحيط بنعمه وعطاياه ومحامده..
ولهذا حمد نفسه بنفسه ( الحمد لله رب العالمين )
لأنه لا يقدر على الحمد حقاًّ إلا من أحاط بالأفعال
الكريمة كلها .. والمحامد كلها .. وذلك أمر لا يعرفه عن الله إلا الله ذاته
ولهذا حمد نفسه بنفسه.. فهو .. الحامد المحمود..
المستحق للحب الكامل دون العالمين ..
وحسبنا نحن أن نتبادل من الحب المودة والرحمة..
وحتى على هذا لا يقدر إلا القادرون .
*****
_________________________________________________
ملخص ما جرى ..
احمد خيري العمري ، البوصلة القرآنية
قد تكون أيها القارئ بعد كل شيء أو
قبل كل شيء مسلماً طيباً صالحاً على قدر استطاعتك.
قد تنوي دوماً وتضمر هذه النية في أن
تكون أفضل.
وقد تتركز هذه النية على تطوير مستوى
أدائك للشعائر خاصة: مزيداً من الخشوع في الصلاة، مزيداً من الصلاة نفسها، الفرائض
على وقتها، وربما جماعة، وكأحسن ما يكون، والنوافل زيادة خير ومزيداً من القربى
لله عزّ وجل.
والرغبة نفسها تتجه نحو كلّ الشعائر:
الصوم مثلاً، الفرض خصوصاً، وستة شوال والليالي البيض من كلّ شهر، خصوصاً رجب
وشعبان وبقية الأيام التي سنّ الرسول (ص) صيامها.
والحج؟ بالتأكيد تنوي أن تحج ليغفر
الله لك ذنبك كله، وتمحو صفحة سيئاتك القديمة، وتبدأ من جديد كما لو ولدتك أمك
للتو.
وقد تكون بشكل عام تريد أن تكون حياتك
أقرب إلى مفهوم الالتزام، طاعات أكثر ومعاصي أقل ويشمل ذلك رغبتك نحو أسرتك: زوجتك
خصوصاً، ملابسها وحجابها على الأخص وأولادك البنات منهن خاصة، ملابسهن وحجابهن
خصوصاً.
وقد تتأثر بنسب متفاوتة بأوضاع إخوانك
المسلمين في كلّ مكان: الشيشان وفلسطين وأفغانستان والبوسنة والجزائر وفي كل مكان،
وقد تتحدث عن ذلك بتأثر حقيقي، ودونما رياء في مجالسك الخاصة، وقد لا تنسى أن تدعو
لهم في صلاتك ولكلّ المسلمين في كلّ مكان.
قد تكون المواصفات السابقة تنطبق عليك
أو على نواياك.
وقد لا تنطبق تماماً لكنها قريبة من
فهمك وأدائك.
* * *
وقد تكون أيها القارئ مختلفاً عن هذا
النموذج الملتزم، قد تكون أكثر تهاوناً في أداء الفرائض وأقل انتظاماً في أداء
الصلوات، ولكنك عموماً تؤمن بالدين وتحبه، لذلك تحاول أن تلزم العصا من النصف، كما
تقنع نفسك، فتتمتع بمباهج الحياة وملذاتها، وإن ارتكبت بعض المعاصي وحتى
الكبائر، وتطمع بعد ذلك – في مواسم العبادات خصوصاً – حيث يزيد الأجر أضعافاً في
مغفرة الله سبحانه وتعالى.
ولعلك لا تشعر بنفسك غريباً في فهمك
وتطبيقك لهذا النوع من الحياة، على العكس إن فهمك هو الشائع وهو السائد منذ قرون
ويمارسه أحياناً أشخاص يدل مفهومهم على التزام شديد، بكل حرفيات الهيئة والسنن،
لكنهم مع ذلك يمسكون العصا من النصف في بعض الأمور، ولعلك تقول لنفسك وأنت ترى
هؤلاء وغيرهم يفعلون ويفعلون تقول: «حشر مع الناس عيد».
ولعلك بقصد أو بدون قصد تجد تبريراً
وسنداً لتصرفاتك هذه في نصوص نبوية – مجتزأة من سياقها العام كالعادة – تعدك بمغفرة
مجانية لكبائرك ومعاصيك، إذا كنت موحداً أو قلت كذا ألف مرة أو أو إلخ، نصوص كهذه
تزرع الرجاء فيك في مغفرة الله وجنته، وليس ذلك بعد كلّ شيء على الله بعزيز.
ولعلك أيضاً يحزنك وضع إخوتك المسلمين
في كلّ مكان، لكن لا يصل الأمر لدرجة ذرف الدموع وإلقاء الخطب بالنسبة إليك، ولا
حتى لدرجة أن تدعو لهم في الصلاة، إذ إن صلاتك أصلاً، إن أنت أديتها قد لا تعدو أن
تكون نقرات سريعة لن تجد فلسطين أو الشيشان وقتاً فيها، لكنك عموماً تتعاطف معهم،
عندما تشاهد نشرات الأخبار وتحس بالغيرة تجاه ما يحدث، وربما يصل الأمر بوعيك أن تشعر
بأنك أنت أيضاً مستهدف كما هم مستهدفون، وأن الدور قد يأتي عليك ما دمت مسلماً،
وقد تقول في نفسك أو أمام أصدقائك: إننا يجب أن نتحد مثلاً، أو يجب أن نفعل كذا
إلخ.
وقد ينطبق عليك هذا الوصف أو لا ينطبق
بنسب متفاوتة.
لكن بالتأكيد فيك شيء من هذا الوصف.
* * *
وسواء كنت أقرب إلى الفهم الأول أو
الفهم الثاني.
فإنك ولا بدّ، تستشعر بأن ثمة شيء خطأ
في واقعنا، وفي حياتنا بشكل عام.
لا بدّ أنك تشعر بأن الأمور ليست على
ما يرام، ولا كما يجب، ولا كما تتمنى أن تكون.
وقد تكون في أعماقك تحس بأن ثمة حاجة
ملحة إلى فهم جديد للدين على الأقل في بعض الأمور المعاصرة المستجدة، إن لم يكن في
الكثير من الأمور المختلف عليها مذهبياً.. ولعلك أكثر من هذا تكون قد أحسست عبر
رحلتنا مع الخطاب القرآني وتشكيله للعقل المسلم أن التاريخ والسياسة قد أسقطتا بعض
العناصر من فهمنا للقرآن وأننا فعلاً خسرنا بعض الجوانب الإيجابية من تفسيرنا
وتأويلنا للقرآن.
ولعلك مقتنع أو أنك قد اقتنعت بأننا
نحتاج إلى رؤية جديدة ومتجددة للدين، من أجل النهوض بمجتمعاتنا وأمتنا.. خاصة في
مواجهة التحديات العالمية الجديدة المتمثلة بقوى العولمة التي تطمس – ضمن ما تطمس
– الهوية القومية والدينية والشخصية المحلية بل والأممية.. ولعلك تقول بأن الإسلام
هو السبيل الوحيد لمواجهة ذلك كله.
ولعلك تردد أيضاً عبارات شديدة الرواج
حالياً مثل (الإسلام هو الحل).. (والمستقبل لهذا الدين).. وتضعها في إطار المشاكل
الحالية، التي تواجه الفرد والمجتمع المسلمين.
وكلّ ذلك جيد جداً.
لكن المشكلة هي أنك خلال ذلك كله لا
تزال خارج الموضوع، تراقب وتشاهد التطورات، كما لو كانت مجرد أحداث في مسلسل شائق
أو غير شائق. تعلق أحياناً على الأحداث، تستنكر هنا وتصفق هناك، لكن لا دور لك في
أحداثه، ويفصل بينك وبين أبطاله شاشة التلفاز الجامدة الباردة. إن الأحداث هنا قد
انتهت عملياً، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعرضها عليك لن يغير فيها شيء. إنك مجرد
متفرج.
المشكلة أنك تحس أن الأمر لا يعنيك
بشكل مباشر، لا دور لك فيه، لا يمكن لك أن تتصور أنك أنت العبد الحقير لك دور في
كلام كبير كهذا: تجديد الدين أو تجدد فهمه.
إنك تعي أن الواقع وإرهاصاته وظواهره
سيئ جداً، وأن التغيير عبر الدين صار حتماً ولا فرار منه، لكن لا مكان لك على
خارطة هذا التغيير.
ولعلّ المسألة في النهاية، ولنعترف،
لا تهمك بشكل كبير شخصياً، لأنك لا تحس بكبير ربط بينها وبين حياتك الشخصية. نعم!
إن الواقع المرير يفرض شروطاً صعبة عليك ويحاربك في لقمة رغيفك، وحليب أطفالك،
ويتركك وأنت تلهث خلفه من أجل أن تسايره وتماشيه، ومع ذلك فأنت بالضبط لا تستشعر
كيف سيؤدي تجديد الدين إلى أن يغير من هذا الواقع الشخصي جداً.
فلنعترف أكثر: حتى هذا الواقع لم يعد
بالنسبة إليك شخصياً جداً.
بمعنى أن تغييره ليس هماً من همومك،
فلقد تعودت عليه بالرغم من الصعوبات والمشاق التي تصل لدرجة الذل والمرار.
لم تتعود عليه، بالضبط لقد عودوك
عليه: الصبر الطيب، والله يحب الصابرين، والقسمة والمقدر والمكتوب، و {قُلْ لَنْ
يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} والصبر مفتاح الفرج إلخ من النصوص
والمقتطفات الصحيحة في سياق آخر بالتأكيد، وليس في سياق الذل والهوان والاستسلام.
لقد اعتدت واقعك. لا يخلو الأمر من
تذمر هنا واحتجاج هناك، لكنك تعودت حالك حال مئات الملايين المستغلة في كلّ مكان،
وربما يكون استغلالك في عالمنا الإسلامي أكثر من أماكن أخرى لكنك تعودت وانتهى
الأمر.
لقد نمت فيك وبقوة غريزة القطيع،
غريزة (حشر مع الناس عيد) وما دامت الناس مستسلمة لهذا الواقع تلهث خلفه لتحسن
وضعها، فأنت معهم حالك حال القطيع الصامت بالرغم من أنه يعي تهيئته للذبح.
حتى الواقع المر تعودته، ولم يعد
يثيرك أن تفكر في تغييره، كلّ ما تفكر فيه وضع أفضل ضمن الواقع نفسه، لكنك لا تفكر
بتغيير الواقع كله، لا بإمكانية ذلك، ولا بإمكانيتك ضمن ذلك، ولا حتى بإمكانية أن
يحدث ذلك ضمن جيلك أو في حياتك.
لا فائدة منا، من جيلنا، لقد
انتهينا.. فلننظر بأتجاه آخر.
* * *
بالرغم من أن أولادك يكونون أحياناً
شياطين صغار، فإنهم على الأغلب لن يكونوا كذلك أثناء نومهم.
اذهب إليهم وتأملهم أثناء ذلك، إذ
ربما لا مجال للتأمل في أي شيء إلا وهم نيام.
اذهب إليهم وانظر إليهم. وتأملهم.
سواء كانوا نياماً في أسرة وثيرة
دافئة وغرف منفصلة مليئة بالهدايا والألعاب، أو كانوا يتكومون الواحد فوق الآخر
على الأرض في حجرة واحدة، قد تكون الحجرة نفسها التي تنام أنت فيها أيضاً.
سواء كانت غرفتهم مكيفة طيلة السنة،
أو كنت لا تملك شتاءً سوى مدفأة واحدة تبيعها في الصيف لتشتري مروحة.
وسواء كانوا يلتحفون بأغطية تفوح منها
رائحة الأحلام الوردية أو كانوا يتغطون بملاحف قديمة بالية لا تكاد تقيهم من
البرد.
وسواء كنت تعود إليهم بعد يوم عملك
بهدايا ثمينة غالية، أو كنت تعود خالي الوفاض، حتى من حلوى رخيصة.
وسواء كانوا جميلين فعلاً وليس بعينيك
فقط، أو كانوا دون ذلك، لكن عيونك تبصرهم أجمل الأطفال.
وسواء كلّ هذا وكلّ ذاك: إنهم أولادك!
وأنت تحبهم أكثر من أي شيء، وبالرغم من كل المثاليات فإنهم عملياً الشيء الوحيد
الذي يستحق بالنسبة إليك، فأنت تضحي بنفسك من أجلهم.
انظر إليهم وتأملهم. عجيب كيف يتحول
شياطين النهار إلى ملائكة صغار أثناء النوم.
قد تنحني بهدوء على جبين واحد منهم
لتقبله، قبلة واحدة فقط، إذ إنك تخاف لو استرسلت في عواطفك أكثر أن يقوم الشيطان
الصغير بقدرة قادر، ووقتها قد يصعب عليك إرجاع الملاك النائم.
انظر إليهم وتأملهم. إنهم أجمل أحلامك
لا شيء عندك مهما كنت غنياً أو فقيراً أغلى منهم، من صحتهم وعافيتهم وضحكتهم.
إنهم رصيدك كله!
لكنك لو فكرت وأنت تتأملهم بما يحاك
لهم وما يرصدونه لهم من مستقبل مظلم، فإن الصورة الوردية لملائكتك الصغار ستختفي،
وستحل محلها صورة أكثر قتامة، تتطلب منك أن تمعن النظر فيها.
إنك على العموم تتمنى لهم مستقبلاً
أفضل من حاضرك، تقول ذلك بصورة عمومية ومن دون تفاصيل. لكنك لو حسبتها (حساب
عرب) كما يقولون، لوجدت أن الأمور ليست كما تتمنى، ولن تكون كذلك، فالأمور تتدهور
باستمرار وأنت نفسك تدهورت على عهدك الأمور بشكل واضح، بل إن معدل التدهور يتسارع
باستمرار، وعندما يكبر ملائكتك الصغار سيواجهون واقعاً صعباً ومريراً بشتى
المقاييس. حتى حاضرك المرير الذي لا تتمناه مستقبلاً لهم، سيكون بالنسبة إليهم
ماضياً جميلاً مريحاً مقارنة بأوضاعهم وقتها.
في عهد أولادك عندما يكبرون، سيزداد
نضوب الثروات المعدنية التي كانت تشكل الغطاء النقدي لاقتصاد معظم البلدان
الإسلامية، وسيعني ذلك أن معظم الخدمات التي توافرت لك في عهد طفولتك وربما حتى
الآن ستختفي، أو لن تصير بالمجان كما كانت من قبل.
وستكون مقولة (التعليم كالماء
والهواء) التي نشأ عليها جيلنا، والتي كانت تعني مجانية التعليم، مقولة مضحكة،
فالتعليم لن يكون مجانياً لأنه منذ الآن لم يعد كذلك.
ولعلّ المقولة لن تكون مضحكة جداً بعد
كلّ شيء، فالماء أيضاً لن يكون مجانياً أو شبه مجاني كما هو الآن، ها هم اليوم
يقتسمون دجلة والفرات، ويخططون لاقتسام النيل أيضاً كخطوة أولى لما هو آت، بل
ويبشروننا أيضاً بأن حروب العصر القادم ستكون حروب المياه كما لو كانت حروب
الأراضي قد انتهت!
ولعلّ المقولة ستكون صادقة تماماً
وحتى الهواء سيتعرض لضريبة تلوث أو أوزون.. أو.. أو.. وستأتي تلك الشركات العملاقة
عابرة القارات لتبيع لأولادنا حتى الهواء الذي يستنشقونه بعدما باعت لهم قبل ذلك
الماء والتعليم والدواء والحليب وكل ما سيبدو ضرورياً للحياة بفعل وسائل الإعلام:
من البيبسي كولا إلى جهاز التلفاز.
حتى الحق في العيش ستبيعه لهم شركات
العولمة!
وسيكون هناك أجهزة وخدمات تقنية
متطورة، حتماً كما هو اليوم وأكثر تقدماً، وأشد انتشاراً، لكن الجانب الآخر لها
سيكون أنها ستفيض المزيد من الأيدي العاملة، وسيزداد طابور البطالة طولاً
..وبما أن معدلات الولادة والنمو السكاني ستكون في ازدياد مستمر، فإن أعداد
العاطلين عن العمل المركونين على الحائط ستكون أكثر من أي وقت مضى، وقسم من هؤلاء
سيكونون أولادك أو أولاد غيرك حتماً، ملائكة صغار أيضاً يحلم لهم آباؤهم اليوم
بمستقبل أفضل من الواقع المرير.
ولأن للعولمة قوانينها الخاصة، فإن
هناك سيكون أغنياء غنى فاحشاً لكن نسبتهم ستكون أقل، وسيكون هناك فقراء، كما في
كلّ زمان ومكان لكن نسبتهم ستكون أكثر.
ولأن ثنائية الغنى الفاحش والفقر
المدقع لا يمكن إلا أن تصحب معها الجريمة، فإن معدلات الجريمة كظاهرة اجتماعية
ستزداد، وفي كلّ جريمة يكون هناك مجرم وضحية، وأي واحد من هؤلاء الملائكة الصغار –
أولادك أو أولاد غيرك – قد ينتمي لأي من الفئتين المجرم أو الضحية.
وفي بلاد كبلداننا عندما يختلط الظلم
الاجتماعي والفقر المدقع والاستغلال بالنعرات الطائفية والأحقاد الدموية القديمة،
فإن المنطقة كلها تصير معرضة للانفجار.
وسيكون ثمن ذلك كله باهظاً جداً!
وسيكون على الأغلب مدفوعاً من سائل
أحمر اللون، عندما يسير الدم ولو قليلاً جراء سقوط بسيط على الأرض تهلع أنت زوجتك
وتهرعان إلى المستشفى.
نعم سيكون الثمن من ذلك السائل الأحمر
الذي يسري في عروق أولادك، أغلى ما عندك.
انظر إليهم وتأملهم ستحتضنهم بشدة،
ولن تبالي لو أيقظتهم من نومتهم.
ستفعل أ ي شيء حتى لا يحدث ذلك.
أترى؟ الآن فقط صار الأمر شخصياً
جداً.
* * *
من أقاصي اليأس يولد منتهى الأمل
عندما تصل لدرجة مرعبة من اليأس يولد
في نفسك ذلك الأمل، الذي يبدو للوهلة الأولى خرافياً أسطورياً مثل نبتة الأقاصيص.
من أقاصي اليأس، عندما تحاصرك رؤيتك
لمستقبل أولادك وهم يختارون أن يكونون مجرمين أو ضحايا في مجتمع سيكون ضحية
بلا شك، تلك الرؤية التي ستدفع بك إلى أن تحتضنهم، كما لو كنت تحاول أن تحميهم
منها …من تلك النقطة البعيدة الموغلة في أقاصي اليأس يتولد عندك الأمل، منتهى
الأمل، الأمل بأن هناك خياراً آخر. الأمل بأن هناك طريق آخر للغد سيسلكه أولادك.
الأمل بأن الحتميات التي يرصدونها لها ليست حتمية بعد كل شيء، وأنهم بالرغم من كلّ
شيء ليسوا الواحد القهار، وأن الأمور قد تخرج عن سياقاتها المرسومة.
من أقاصي اليأس سيولد عندك الأمر بأن
في مقدورك شيء.
ولأنك يائس وتحتضن صغارك مثل قطة
مذعورة في ليلة قصف مجنون، فإن الأمل الذي يتولد من يأسك ليس أمل الشعارات الرنانة
ولا الخطب الحماسية ولا الأناشيد.
بل أمل العمل والقدرة على التغيير،
أمل الكفاح والتشبث الحقيقي بالحياة.
الأمل الذي يتحد مع الوعي الجاد
والبصيرة المنفتحة على شتى الاحتمالات.
الأمل الذي يولد من أقاصي اليأس يكون
أملاً متعايشاً مع حقيقة أن الغد الذي نريده لا يأتي فجأة، ومن دون مقدمات، الغد
الذي نريده ليس يوماً جديداً نلاقيه، عندما نستيقظ صباحاً، بل هو الغد الذي يبدأ
صنعه في يومنا: نصنعه، نحن نخطط له، ونرسمه في يومنا هذا، وقبل أن يبدأ الغد بزمن
طويل.
إنه الأمل الذي يعي تماماً بأن الحاضر
المرير الباعث على اليأس لم يبدأ فجأة، بل بدأ في أمس بعيد جداً وأن المستقبل الذي
يرصدونه لأولادك هو الامتداد الطبيعي للأمس واليوم.
إنه الأمل الذي يدرك بأن دواء
المستقبل يجب أن يستخرج من أمراض الحاضر، ومن تشخيص عوامل الأمس التي أدت إلى
أمراض الحاضر. إنه الأمل الذي ينمو في بوتقة ينصهر فيه الأمس واليوم والغد في
ترابط لا فكاك عنه.
عوامل الأمس، أمراض اليوم ودواء الغد
هي التركيبة التي يتكون منها هذا الحل.
لعلك تقول إنه أمل صغير؟ نعم أمل
صغير، مثل أولادك الصغار.
وكما تتمنى أن تراهم وهم يحبون،
ويمشون ويكبرون، راقبه وهو يحبو ويكبر.
لكن الأهم ألاّ يظل مجرد أمل، بل ينمو
ليصير ، مشروع حضارة وفكر..مشروع نهضة.
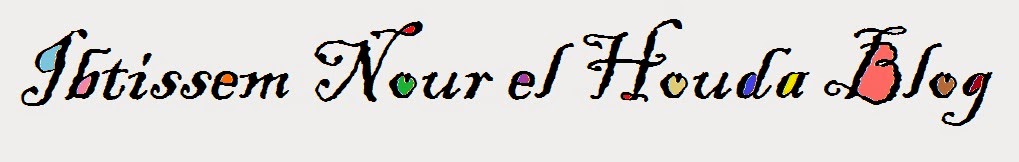









ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق